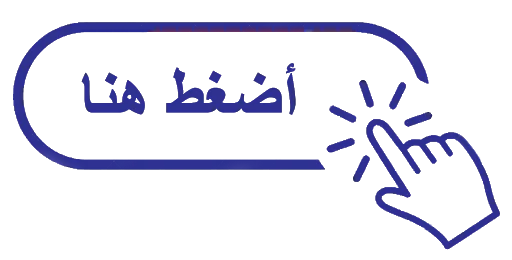كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ↓
↓
 ↓
↓يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع, والنعم المتممة, ليس ذلك ببدع من إحساننا, ولا بأوله, بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها, فأبلغها, إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم, تعرفون نسبه وصدقه, وأمانته وكماله ونصحه.
" يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا " وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها.
فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل, والهدى من الضلال, التي دلتكم أولا, على توحيد الله وكماله, ثم على صدق رسوله, ووجوب الإيمان به, ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب, حتى حصل لكم الهداية التامة, والعلم اليقيني.
" وَيُزَكِّيكُمْ " أي يطهر أخلاقكم ونفوسكم, بتربيتها على الأخلاق الجميلة, وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة, وذلك كتزكيتكم من الشرك, إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاص, ومن الكذب إلى الصدق, ومن الخيانة إلى الأمانة, ومن الكبر إلى التواضع, ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق, ومن التباغض والتهاجر والتقاطع, إلى التحابب والتواصل والتوادد, وغير ذلك من أنواع التزكية.
" وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ " أي: القرآن, ألفاظه ومعانيه.
" وَالْحِكْمَةَ " قيل: هي السنة, وقيل: الحكمة, معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها, وتنزيل الأمور منازلها.
فيكون - على هذا - تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب, لأن السنة, تبين القرآن وتفسره, وتعبر عنه.
" وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ " لأنهم كانوا قبل بعثته, في ضلال مبين, لا علم ولا عمل.
فكل علم أو عمل, نالته هذه الأمة فعلى يده صلى الله عليه وسلم, وبسببه كان.
فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق, وهي أكبر نعم ينعم بها على عباده.
فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها.
" يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا " وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها.
فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل, والهدى من الضلال, التي دلتكم أولا, على توحيد الله وكماله, ثم على صدق رسوله, ووجوب الإيمان به, ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب, حتى حصل لكم الهداية التامة, والعلم اليقيني.
" وَيُزَكِّيكُمْ " أي يطهر أخلاقكم ونفوسكم, بتربيتها على الأخلاق الجميلة, وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة, وذلك كتزكيتكم من الشرك, إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاص, ومن الكذب إلى الصدق, ومن الخيانة إلى الأمانة, ومن الكبر إلى التواضع, ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق, ومن التباغض والتهاجر والتقاطع, إلى التحابب والتواصل والتوادد, وغير ذلك من أنواع التزكية.
" وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ " أي: القرآن, ألفاظه ومعانيه.
" وَالْحِكْمَةَ " قيل: هي السنة, وقيل: الحكمة, معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها, وتنزيل الأمور منازلها.
فيكون - على هذا - تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب, لأن السنة, تبين القرآن وتفسره, وتعبر عنه.
" وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ " لأنهم كانوا قبل بعثته, في ضلال مبين, لا علم ولا عمل.
فكل علم أو عمل, نالته هذه الأمة فعلى يده صلى الله عليه وسلم, وبسببه كان.
فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق, وهي أكبر نعم ينعم بها على عباده.
فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها.
فلهذا قال تعالى " فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ " فأمر تعالى بذكره, ووعد عليه أفضل جزاء, وهو ذكره لمن ذكره, كما قال تعالى على لسان رسوله " من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم " .
وذكر الله تعالى, أفضله, ما تواطأ عليه القلب واللسان, وهو الذي يثمر معرفة الله ومحبته, وكثرة ثوابه.
والذكر هو رأس الشكر, فلهذا أمر به خصوصا, ثم من بعده أمر بالشكر عموما فقال: " وَاشْكُرُوا لِي " أي: على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم.
والشكر يكون بالقلب, إقرارا بالنعم, واعترافا, وباللسان, ذكرا وثناء, وبالجوارح, طاعة لله وانقيادا لأمره, واجتنابا لنهيه, فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة, وزيادة في النعم المفقودة.
قال تعالى " لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ " .
وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية, من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال, بيان أنها أكبر النعم, بل هي النعم الحقيقية؟ التي تدوم, إذا زال غيرها.
وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل, أن يشكروا الله على ذلك, ليزيدهم من فضله, وليندفع عنهم الإعجاب, فيشتغلوا بالشكر.
ولما كان الشكر ضده الكفر, نهى عن ضده فقال " وَلَا تَكْفُرُونِ " المراد بالكفر ههنا, ما يقابل الشكر, فهو كفر النعم وجحدها, وعدم القيام بها.
ويحتمل أن يكون المعنى عاما, فيكون الكفر أنواعا كثيرة, أعظمه الكفر بالله, ثم أنواع المعاصي, على اختلاف أنواعها وأجناسها, من الشرك, فما دونه.
وذكر الله تعالى, أفضله, ما تواطأ عليه القلب واللسان, وهو الذي يثمر معرفة الله ومحبته, وكثرة ثوابه.
والذكر هو رأس الشكر, فلهذا أمر به خصوصا, ثم من بعده أمر بالشكر عموما فقال: " وَاشْكُرُوا لِي " أي: على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم.
والشكر يكون بالقلب, إقرارا بالنعم, واعترافا, وباللسان, ذكرا وثناء, وبالجوارح, طاعة لله وانقيادا لأمره, واجتنابا لنهيه, فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة, وزيادة في النعم المفقودة.
قال تعالى " لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ " .
وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية, من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال, بيان أنها أكبر النعم, بل هي النعم الحقيقية؟ التي تدوم, إذا زال غيرها.
وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل, أن يشكروا الله على ذلك, ليزيدهم من فضله, وليندفع عنهم الإعجاب, فيشتغلوا بالشكر.
ولما كان الشكر ضده الكفر, نهى عن ضده فقال " وَلَا تَكْفُرُونِ " المراد بالكفر ههنا, ما يقابل الشكر, فهو كفر النعم وجحدها, وعدم القيام بها.
ويحتمل أن يكون المعنى عاما, فيكون الكفر أنواعا كثيرة, أعظمه الكفر بالله, ثم أنواع المعاصي, على اختلاف أنواعها وأجناسها, من الشرك, فما دونه.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ↓
↓
 ↓
↓أمر الله تعالى المؤمنين, بالاستعانة على أمورهم الدنيوية " بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ " .
فالصبر هو: حبس النفس وكفها عما تكره, فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله, حتى تؤديها, وعن معصية الله حتى تتركها, وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها.
فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر, فلا سبيل لغير الصابر, أن يدرك مطلوبه.
وخصوصا, الطاعات الشاقة المستمرة, فإنها مفتقرة أشد الافتقار, إلى تحمل الصبر, وتجرع المرارة الشاقة.
فإذا لازم صاحبها الصبر, فاز بالنجاح, وإن رده المكروه والمشقة, عن الصبر والملازمة عليها, لم يدرك شيئا, وحصل على الحرمان.
وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد.
فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم, وكف لدواعي قلبه ونوازعها, لله تعالى, واستعانة بالله على العصمة منها, فإنها من الفتن الكبار.
وكذلك البلاء الشاق, خصوصا إن استمر, فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية, ويوجد مقتضاها, وهو التسخط, إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله, والتوكل عليه, واللجأ إليه, والافتقار على الدوام.
فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد, بل مضطر إليه في كل حالة من أحواله.
فلهذا أمر الله تعالى به, وأخبر أنه " مَعَ الصَّابِرِينَ " أي: مع من كان الصبر لهم خلقا, وصفة, وملكة - بمعونته وتوفيقه, وتسديده.
فهانت عليهم بذلك, المشاق والمكاره, وسهل عليهم كل عظيم, وزالت عنهم كل صعوبة.
وهذه معية خاصة, تقتضي محبته ومعونته, ونصره وقربه, وهذه منقبة عظيمة للصابرين.
فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله, لكفى بها فضلا وشرفا.
وأما المعية العامة, فهي معية العلم والقدرة, كما في قوله تعالى: " وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ " وهذه عامة للخلق.
وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين, ونور المؤمنين, وهي الصلة بين العبد وبين ربه.
فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة, مجتمعا فيها ما يلزم فيها, وما يسن, وحصل فيها حضور القلب, الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها, استشعر دخوله على ربه, ووقوفه بين يديه, موقف العبد الخادم المتأدب, مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله, مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه - لا جرم أن هذه الصلاة, من أكبر المعونة على جميع الأمور فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة, يوجب للعبد في قلبه, وصفا, وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه, واجتناب نواهيه.
هذه هي الصلاة التي أمر الله, أن نستعين بها على كل شيء.
فالصبر هو: حبس النفس وكفها عما تكره, فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله, حتى تؤديها, وعن معصية الله حتى تتركها, وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها.
فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر, فلا سبيل لغير الصابر, أن يدرك مطلوبه.
وخصوصا, الطاعات الشاقة المستمرة, فإنها مفتقرة أشد الافتقار, إلى تحمل الصبر, وتجرع المرارة الشاقة.
فإذا لازم صاحبها الصبر, فاز بالنجاح, وإن رده المكروه والمشقة, عن الصبر والملازمة عليها, لم يدرك شيئا, وحصل على الحرمان.
وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد.
فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم, وكف لدواعي قلبه ونوازعها, لله تعالى, واستعانة بالله على العصمة منها, فإنها من الفتن الكبار.
وكذلك البلاء الشاق, خصوصا إن استمر, فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية, ويوجد مقتضاها, وهو التسخط, إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله, والتوكل عليه, واللجأ إليه, والافتقار على الدوام.
فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد, بل مضطر إليه في كل حالة من أحواله.
فلهذا أمر الله تعالى به, وأخبر أنه " مَعَ الصَّابِرِينَ " أي: مع من كان الصبر لهم خلقا, وصفة, وملكة - بمعونته وتوفيقه, وتسديده.
فهانت عليهم بذلك, المشاق والمكاره, وسهل عليهم كل عظيم, وزالت عنهم كل صعوبة.
وهذه معية خاصة, تقتضي محبته ومعونته, ونصره وقربه, وهذه منقبة عظيمة للصابرين.
فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله, لكفى بها فضلا وشرفا.
وأما المعية العامة, فهي معية العلم والقدرة, كما في قوله تعالى: " وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ " وهذه عامة للخلق.
وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين, ونور المؤمنين, وهي الصلة بين العبد وبين ربه.
فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة, مجتمعا فيها ما يلزم فيها, وما يسن, وحصل فيها حضور القلب, الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها, استشعر دخوله على ربه, ووقوفه بين يديه, موقف العبد الخادم المتأدب, مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله, مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه - لا جرم أن هذه الصلاة, من أكبر المعونة على جميع الأمور فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة, يوجب للعبد في قلبه, وصفا, وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه, واجتناب نواهيه.
هذه هي الصلاة التي أمر الله, أن نستعين بها على كل شيء.
وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ ↓
↓
 ↓
↓لما ذكر تبارك وتعالى, الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال, ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه, وهو الجهاد في سبيله, وهو أفضل الطاعات البدنية, وأشقها على النفوس, لمشقته في نفسه, ولكونه مؤديا للقتل, وعدم الحياة, التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها.
فكل ما يتصرفون به, فإنه سعى لها, ودفع لما يضادها.
ومن المعلوم, أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم.
فأخبر تعالى: أن من قتل في سبيله, بأن قاتل في سبيل الله, لتكون كلمة الله هي العليا, ودينه الظاهر, لا لغير ذلك من الأغراض, فأنه لم تفته الحياة المحبوبة, بل حصل له حياة أعظم وأكمل, مما تظنون وتحسبون.
فالشهداء " أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ " .
فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى, وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة, والرزق الروحي, وهو الفرح.
وهو الاستبشار, وزوال كل خوف وحزن.
وهذه حياة برزخية, أكمل من الحياة الدنيا.
بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة, وتأكل من ثمارها, وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش.
وفي هذه الآية, أعظم حث على الجهاد في سبيل الله, وملازمة الصبر عليه.
فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب, لم يتخلف عنه أحد.
ولكن عدم العلم اليقيني التام, هو الذي فتر العزائم, وزاد نوم النائم, وأفات الأجور العظيمة والغنائم.
لم لا يكون كذلك والله تعالى قد " اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ " .
فوالله لو كان للإنسان ألف نفس, تذهب نفسا فنفسا في سبيل الله, لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم.
ولهذا لا يتمنى الشهداء - بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه - إلا أن يردوا إلى الدنيا, حتى يقتلون في سبيله مرة بعد مرة.
وفي الآية, دليل على نعيم البرزخ وعذابه, كما تكاثرت بذلك النصوص.
فكل ما يتصرفون به, فإنه سعى لها, ودفع لما يضادها.
ومن المعلوم, أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم.
فأخبر تعالى: أن من قتل في سبيله, بأن قاتل في سبيل الله, لتكون كلمة الله هي العليا, ودينه الظاهر, لا لغير ذلك من الأغراض, فأنه لم تفته الحياة المحبوبة, بل حصل له حياة أعظم وأكمل, مما تظنون وتحسبون.
فالشهداء " أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ " .
فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى, وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة, والرزق الروحي, وهو الفرح.
وهو الاستبشار, وزوال كل خوف وحزن.
وهذه حياة برزخية, أكمل من الحياة الدنيا.
بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة, وتأكل من ثمارها, وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش.
وفي هذه الآية, أعظم حث على الجهاد في سبيل الله, وملازمة الصبر عليه.
فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب, لم يتخلف عنه أحد.
ولكن عدم العلم اليقيني التام, هو الذي فتر العزائم, وزاد نوم النائم, وأفات الأجور العظيمة والغنائم.
لم لا يكون كذلك والله تعالى قد " اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ " .
فوالله لو كان للإنسان ألف نفس, تذهب نفسا فنفسا في سبيل الله, لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم.
ولهذا لا يتمنى الشهداء - بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه - إلا أن يردوا إلى الدنيا, حتى يقتلون في سبيله مرة بعد مرة.
وفي الآية, دليل على نعيم البرزخ وعذابه, كما تكاثرت بذلك النصوص.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ↓
↓
 ↓
↓أخبر تعالى, أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن, ليتبين الصادق من الكاذب, والجازع من الصابر, وهذه سنته تعالى في عباده.
لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان, ولم يحصل معها محنة, لحصل الاختلاط الذي هو فساد, وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر.
هذه فائدة المحن, لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان, ولا ردهم عن دينهم, فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين.
فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده " بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ " من الأعداء " وَالْجُوعِ " أي: بشيء يسير منهما.
لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله, أو الجوع, لهلكوا, والمحن تمحص لا تهلك.
" وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ " وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال, من جوائح سماوية, وغرق, وضياع, وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة, وقطاع الطريق وغير ذلك.
" وَالْأَنْفُسِ " أي ذهاب الأحباب, من الأولاد, والأقارب, والأصحاب, ومن أنواع الأمراض في بدن العبد, أو بدن من يحبه.
" وَالثَّمَرَاتِ " أي الحبوب, وثمار النخيل, والأشجار كلها, والخضر ببرد, أو برد, أو حرق, أو آفة سماوية, من جراد ونحوه.
فهذه الأمور, لا بد أن تقع, لأن العليم الخبير, أخبر بها, فوقعت كما أخبر.
فإذا وقعت, انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين.
فالجازع, حصلت له المصيبتان, فوات المحبوب, وهو وجود هذه المصيبة.
وفوات ما هو أعظم منها, وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر.
ففار بالخسارة والحرمان, ونقص ما معه من الإيمان.
وفاته الصبر والرضا والشكران, وحصل له السخط الدال على شدة النقصان.
وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب, فحبس نفسه عن التسخط, قولا وفعلا, واحتسب أجرها عند الله, وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره, أعظم من المصيبة التي حصلت له, بل المصيبة تكون نعمة في حقه, لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها, فقد امتثل أمر الله, وفاز بالثواب.
فلهذا قال تعالى " وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ " أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب.
لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان, ولم يحصل معها محنة, لحصل الاختلاط الذي هو فساد, وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر.
هذه فائدة المحن, لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان, ولا ردهم عن دينهم, فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين.
فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده " بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ " من الأعداء " وَالْجُوعِ " أي: بشيء يسير منهما.
لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله, أو الجوع, لهلكوا, والمحن تمحص لا تهلك.
" وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ " وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال, من جوائح سماوية, وغرق, وضياع, وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة, وقطاع الطريق وغير ذلك.
" وَالْأَنْفُسِ " أي ذهاب الأحباب, من الأولاد, والأقارب, والأصحاب, ومن أنواع الأمراض في بدن العبد, أو بدن من يحبه.
" وَالثَّمَرَاتِ " أي الحبوب, وثمار النخيل, والأشجار كلها, والخضر ببرد, أو برد, أو حرق, أو آفة سماوية, من جراد ونحوه.
فهذه الأمور, لا بد أن تقع, لأن العليم الخبير, أخبر بها, فوقعت كما أخبر.
فإذا وقعت, انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين.
فالجازع, حصلت له المصيبتان, فوات المحبوب, وهو وجود هذه المصيبة.
وفوات ما هو أعظم منها, وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر.
ففار بالخسارة والحرمان, ونقص ما معه من الإيمان.
وفاته الصبر والرضا والشكران, وحصل له السخط الدال على شدة النقصان.
وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب, فحبس نفسه عن التسخط, قولا وفعلا, واحتسب أجرها عند الله, وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره, أعظم من المصيبة التي حصلت له, بل المصيبة تكون نعمة في حقه, لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها, فقد امتثل أمر الله, وفاز بالثواب.
فلهذا قال تعالى " وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ " أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب.
فالصابرين, هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة, والمنحة الجسيمة.
ثم وصفهم بقوله " الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ " وهي كل ما يؤلم القلب, أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره.
" قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ " أي: مملوكون لله, مدبرون تحت أمره وتصريفه, فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء.
فإذا ابتلانا بشيء منها, فقد تصرف أرحم الراحمين, بمماليكه وأموالهم, فلا اعتراض عليه.
بل من كمال عبودية العبد, علمه, بأن وقوع البلية من المالك الحكيم, الذي هو أرحم بعبده من نفسه.
فيوجب له ذلك, الرضا عن الله, والشكر له على تدبيره, لما هو خير لعبده,, وإن لم يشعر بذلك.
ومع أننا مملوكون لله, فإنا إليه راجعون يوم المعاد, فمجاز كل عامل بعمله.
فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده.
وإن جزعنا وسخطنا, لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر.
فكون العبد لله, وراجعا إليه, من أقوى أسباب الصبر.
ثم وصفهم بقوله " الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ " وهي كل ما يؤلم القلب, أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره.
" قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ " أي: مملوكون لله, مدبرون تحت أمره وتصريفه, فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء.
فإذا ابتلانا بشيء منها, فقد تصرف أرحم الراحمين, بمماليكه وأموالهم, فلا اعتراض عليه.
بل من كمال عبودية العبد, علمه, بأن وقوع البلية من المالك الحكيم, الذي هو أرحم بعبده من نفسه.
فيوجب له ذلك, الرضا عن الله, والشكر له على تدبيره, لما هو خير لعبده,, وإن لم يشعر بذلك.
ومع أننا مملوكون لله, فإنا إليه راجعون يوم المعاد, فمجاز كل عامل بعمله.
فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده.
وإن جزعنا وسخطنا, لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر.
فكون العبد لله, وراجعا إليه, من أقوى أسباب الصبر.
" أُولَئِكَ " الموصوفون بالصبر المذكور " عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ " أي: ثناء وتنويه بحالهم " وَرَحْمَةٌ " عظيمة.
ومن رحمته إياهم, أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر.
" وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ " الذين عرفوا الحق, وهو في هذا الموضع, علمهم بأنهم لله, وأنهم إليه راجعون, وعملوا به وهو هنا صبرهم لله.
ودلت هذه الآية, على أن من لم يصبر, فله ضد ما لهم, فحصل له الذم من الله, والعقوبة, والضلال والخسارة.
فما أعظم الفرق بين الفريقين " وما أقل تعب الصابرين, وأعظم عناء الجازعين " .
فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها, لتخف وتسهل, إذا وقعت.
وبيان ما تقابل به, إذا وقعت, وهو الصبر.
وبيان ما يعين على الصبر, وما للصابرين من الأجر.
ويعلم حال غير الصابر, بضد حال الصابر.
وأن هذا الابتلاء والامتحان, سنة الله التي قد خلت, ولن تجد لسنة الله تبديلا.
وبيان أنواع المصائب.
ومن رحمته إياهم, أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر.
" وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ " الذين عرفوا الحق, وهو في هذا الموضع, علمهم بأنهم لله, وأنهم إليه راجعون, وعملوا به وهو هنا صبرهم لله.
ودلت هذه الآية, على أن من لم يصبر, فله ضد ما لهم, فحصل له الذم من الله, والعقوبة, والضلال والخسارة.
فما أعظم الفرق بين الفريقين " وما أقل تعب الصابرين, وأعظم عناء الجازعين " .
فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها, لتخف وتسهل, إذا وقعت.
وبيان ما تقابل به, إذا وقعت, وهو الصبر.
وبيان ما يعين على الصبر, وما للصابرين من الأجر.
ويعلم حال غير الصابر, بضد حال الصابر.
وأن هذا الابتلاء والامتحان, سنة الله التي قد خلت, ولن تجد لسنة الله تبديلا.
وبيان أنواع المصائب.
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ↓
↓
 ↓
↓يخبر تعالى " إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ " وهما معروفان " مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ " أي أعلام دينه الظاهرة, التي تعبد الله بها عباده, وإذا كانا من شعائر الله, فقد أمر الله بتعظيم شعائره فقال " وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ " .
فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله, وأن تعظيم شعائره, من تقوى القلوب.
والتقوى واجبة على كل مكلف, وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة, كما عليه الجمهور, ودلت عليه الأحاديث النبوية وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال " خذوا عني مناسككم " .
" فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا " .
هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما, لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام.
فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم, لا لأنه غير لازم.
ودل تقييد نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرة, أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة.
بخلاف الطواف بالبيت, فإنه يشرع مع العمرة والحج, وهو عبادة مفردة.
فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة, ورمي الجمار فإنها تتبع النسك.
فلو فعلت غير تابعة للنسك, كانت بدعة, لأن البدعة نوعان.
نوع يتعبد لله بعبادة, لم يشرعها أصلا.
ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة, فتفعل على غير تلك الصفة, وهذا منه.
وقوله " وَمَنْ تَطَوَّعَ " أي: فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى " خَيْرًا " من حج وعمرة, وطواف, وصلاة, وصوم وغير ذلك " فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ " .
فدل هذا, على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله, ازداد خيره وكماله, ودرجته عند الله, لزيادة إيمانه.
ودل تقييد التطوع بالخير, أن من تطوع بالبدع, التي لم يشرعها الله ولا رسوله, أنه لا يحصل له إلا العناء, وليس بخير له, بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل.
" فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ " الشاكر والشكور, من أسماء الله تعالى, الذي يقبل من عباده اليسير من العمل, ويجازيهم عليه, العظيم من الأجر, الذي إذا قام عبده بأوامره, وامتثل طاعته, أعانه على ذلك, وأثنى عليه ومدحه, وجازاه في قلبه نورا وإيمانا, وسعة, وفي بدنه قوة ونشاطا, وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء, وفي أعماله زيادة توفيق.
ثم بعد ذلك, يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرا, لم تنقصه هذه الأمور.
ومن شكره لعبده, أن من ترك شيئا لله, عوضه الله خيرا منه.
ومن تقرب منه شبرا, تقرب منه ذراعا, ومن تقرب منه ذراعا, تقرب منه باعا, ومن أتاه يمشي, أتاه هرولة, ومن عامله, ربح عليه أضعافا مضاعفة.
ومع أنه شاكر, فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل, بحسب نيته وإيمانه وتقواه, ممن ليس كذلك.
عليم بأعمال العباد, فلا يضيعها, بل يجدونها أوفر ما كانت, على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم.
فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله, وأن تعظيم شعائره, من تقوى القلوب.
والتقوى واجبة على كل مكلف, وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة, كما عليه الجمهور, ودلت عليه الأحاديث النبوية وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال " خذوا عني مناسككم " .
" فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا " .
هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما, لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام.
فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم, لا لأنه غير لازم.
ودل تقييد نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرة, أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة.
بخلاف الطواف بالبيت, فإنه يشرع مع العمرة والحج, وهو عبادة مفردة.
فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة, ورمي الجمار فإنها تتبع النسك.
فلو فعلت غير تابعة للنسك, كانت بدعة, لأن البدعة نوعان.
نوع يتعبد لله بعبادة, لم يشرعها أصلا.
ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة, فتفعل على غير تلك الصفة, وهذا منه.
وقوله " وَمَنْ تَطَوَّعَ " أي: فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى " خَيْرًا " من حج وعمرة, وطواف, وصلاة, وصوم وغير ذلك " فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ " .
فدل هذا, على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله, ازداد خيره وكماله, ودرجته عند الله, لزيادة إيمانه.
ودل تقييد التطوع بالخير, أن من تطوع بالبدع, التي لم يشرعها الله ولا رسوله, أنه لا يحصل له إلا العناء, وليس بخير له, بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل.
" فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ " الشاكر والشكور, من أسماء الله تعالى, الذي يقبل من عباده اليسير من العمل, ويجازيهم عليه, العظيم من الأجر, الذي إذا قام عبده بأوامره, وامتثل طاعته, أعانه على ذلك, وأثنى عليه ومدحه, وجازاه في قلبه نورا وإيمانا, وسعة, وفي بدنه قوة ونشاطا, وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء, وفي أعماله زيادة توفيق.
ثم بعد ذلك, يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرا, لم تنقصه هذه الأمور.
ومن شكره لعبده, أن من ترك شيئا لله, عوضه الله خيرا منه.
ومن تقرب منه شبرا, تقرب منه ذراعا, ومن تقرب منه ذراعا, تقرب منه باعا, ومن أتاه يمشي, أتاه هرولة, ومن عامله, ربح عليه أضعافا مضاعفة.
ومع أنه شاكر, فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل, بحسب نيته وإيمانه وتقواه, ممن ليس كذلك.
عليم بأعمال العباد, فلا يضيعها, بل يجدونها أوفر ما كانت, على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم.
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ ↓
↓
 ↓
↓هذه الآية, وإن كانت نازلة في أهل الكتاب, وما كتموا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته, فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله " مِنَ الْبَيِّنَاتِ " الدالات على الحق المظهرات له.
" وَالْهُدَى " وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم, ويتبين به طريق أهل النعيم, من طريق أهل الجحيم.
فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم, بأن يبينوا الناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه.
فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين, كتم ما أنزل الله, والغش لعباد الله فأولئك " يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ " أي: يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته.
" وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ " وهم جميع الخليقة, فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة, لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم, وإبعادهم من رحمة الله, فجوزوا من جنس عملهم.
كما أن معلم الناس الخير, يصلي الله عليه وملاكته, حتى الحوت في جوف الماء, لسعيه في مصلحة الخلق, وإصلاح أديانهم, وقربهم من رحمة الله, فجوزى من جنس عمله.
فالكاتم لما أنزل الله, مضاد لأمر الله, مشاق لله, يبين الله الآيات للناس ويوضحها.
وهذا يسعى في طمسها وإخفائها فهذا عليه هذا الوعيد الشديد.
" وَالْهُدَى " وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم, ويتبين به طريق أهل النعيم, من طريق أهل الجحيم.
فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم, بأن يبينوا الناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه.
فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين, كتم ما أنزل الله, والغش لعباد الله فأولئك " يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ " أي: يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته.
" وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ " وهم جميع الخليقة, فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة, لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم, وإبعادهم من رحمة الله, فجوزوا من جنس عملهم.
كما أن معلم الناس الخير, يصلي الله عليه وملاكته, حتى الحوت في جوف الماء, لسعيه في مصلحة الخلق, وإصلاح أديانهم, وقربهم من رحمة الله, فجوزى من جنس عمله.
فالكاتم لما أنزل الله, مضاد لأمر الله, مشاق لله, يبين الله الآيات للناس ويوضحها.
وهذا يسعى في طمسها وإخفائها فهذا عليه هذا الوعيد الشديد.
إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ↓
↓
 ↓
↓" إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا " أي رجعوا عما هم عليه من الذنوب, ندما وإقلاعا, وعزما على عدم المعاودة " وَأَصْلَحُوا " ما فسد من أعمالهم.
فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن.
ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضا, حتى يبين ما كتمه, ويبدي ضد ما أخفى.
فهذا يتوب الله عليه, لأن توبة الله غير محجوب عنها.
فمن أتى بسبب التوبة, تاب الله عليه, لأنه " التَّوَّابُ " أي الرجاع على عباده بالعفو والصفح, بعد الذنب إذا تابوا, وبالإحسان والنعم بعد المنع, إذا رجعوا.
" الرَّحِيمِ " الذي اتصف بالرحمة العظيمة, التي وسعت كل شيء.
ومن رحمته, أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأنابوا, ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم, لطفا وكرما, هذا حكم التائب من الذنب.
فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن.
ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضا, حتى يبين ما كتمه, ويبدي ضد ما أخفى.
فهذا يتوب الله عليه, لأن توبة الله غير محجوب عنها.
فمن أتى بسبب التوبة, تاب الله عليه, لأنه " التَّوَّابُ " أي الرجاع على عباده بالعفو والصفح, بعد الذنب إذا تابوا, وبالإحسان والنعم بعد المنع, إذا رجعوا.
" الرَّحِيمِ " الذي اتصف بالرحمة العظيمة, التي وسعت كل شيء.
ومن رحمته, أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأنابوا, ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم, لطفا وكرما, هذا حكم التائب من الذنب.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ↓
↓
 ↓
↓وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات ولم يرجع إلى ربه, ولم ينب إليه, ولم يتب عن قريب فأولئك " عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " .
لأنه لما صار كفرهم وصفا ثابتا, صارت اللعنة عليهم وصفا ثابتا لا تزول, لأن الحكم يدور مع علته, وجودا وعدما.
لأنه لما صار كفرهم وصفا ثابتا, صارت اللعنة عليهم وصفا ثابتا لا تزول, لأن الحكم يدور مع علته, وجودا وعدما.
و " خَالِدِينَ فِيهَا " أي: في اللعنة, أو في العذاب, وهما متلازمان.
و " لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ " بل عذابهم دائم شديد مستمر " وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ " أي: يمهلون, لأن وقت الإمهال - وهو الدنيا - قد مضى, ولم يبق لهم عذر فيعتذرون.
و " لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ " بل عذابهم دائم شديد مستمر " وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ " أي: يمهلون, لأن وقت الإمهال - وهو الدنيا - قد مضى, ولم يبق لهم عذر فيعتذرون.
يخبر تعالى - وهو أصدق القائلين - أنه " إِلَهٌ وَاحِدٌ " أي: متوحد متفرد في ذاته, وأسمائه, وصفاته, وأفعاله.
فليس له شريك في ذاته, ولا سمي له ولا كفو له, ولا مثل, ولا نظير, ولا خالق, ولا مدبر غيره.
فإذا كان كذلك, فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة, ولا يشرك به أحد من خلقه, لأنه " الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " المتصف بالرحمة العظيمة, التي لا يماثلها رحمة أحد, فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي.
فبرحمته وجدت المخلوقات, وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات.
وبرحمته اندفع عنها كل نقمة.
وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه, وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم, بإرسال الرسل, وإنزال الكتب.
فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة, فمن الله, وأن أحدا من المخلوقين, لا ينفع أحدا - علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة, وأن يفرد بالمحبة والخوف, والرجاء, والتعظيم, والتوكل, وغير ذلك من أنواع الطاعات.
وأن من أظلم الظلم, وأقبح القبيح, أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد, وأن يشرك المخلوقين من تراب, برب الأرباب, أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه, مع الخالق المدبر القادر القوي.
الذي قهر كل شيء.
ودان له كل شيء.
ففي هذه الآية, إثبات وحدانية الباري وإلهيته.
وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم, واندفاع جميع النقم.
فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى.
ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال:
فليس له شريك في ذاته, ولا سمي له ولا كفو له, ولا مثل, ولا نظير, ولا خالق, ولا مدبر غيره.
فإذا كان كذلك, فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة, ولا يشرك به أحد من خلقه, لأنه " الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " المتصف بالرحمة العظيمة, التي لا يماثلها رحمة أحد, فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي.
فبرحمته وجدت المخلوقات, وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات.
وبرحمته اندفع عنها كل نقمة.
وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه, وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم, بإرسال الرسل, وإنزال الكتب.
فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة, فمن الله, وأن أحدا من المخلوقين, لا ينفع أحدا - علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة, وأن يفرد بالمحبة والخوف, والرجاء, والتعظيم, والتوكل, وغير ذلك من أنواع الطاعات.
وأن من أظلم الظلم, وأقبح القبيح, أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد, وأن يشرك المخلوقين من تراب, برب الأرباب, أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه, مع الخالق المدبر القادر القوي.
الذي قهر كل شيء.
ودان له كل شيء.
ففي هذه الآية, إثبات وحدانية الباري وإلهيته.
وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم, واندفاع جميع النقم.
فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى.
ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال:
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ↓
↓
 ↓
↓" إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ " الآية.
أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة, آيات أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته.
وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته.
ولكنها " لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ " أي: لمن لهم عقول يعملونها.
فيما خلقت له.
فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل, ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبيره.
ففي " خَلْقِ السَّمَاوَاتِ " في ارتفاعها واتساعها, وإحكامها, وإتقانها, وما جعل الله فيها من الشمس والقمر, والنجوم, وتنظيمها لمصالح العباد.
وفي خلق " الْأَرْضِ " مهادا للخلق, يمكنهم القرار عليها, والانتفاع بما عليها, والاعتبار, ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير, وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها, وحكمته التي بها أتقنها, وأحسنها ونظمها, وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع, من منافع الخلق ومصالحهم, وضروراتهم وحاجاتهم.
وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله, واستحقاقه أن يفرد بالعبادة, لانفراده بالخلق والتدبير, والقيام بشئون عباده.
وفي " اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ " , وهو تعاقبهما على الدوام, إذا ذهب أحدهما, خلفه الآخر.
وفي اختلافهما في الحر, والبرد, والتوسط, وفي الطول, والقصر, والتوسط, وما ينشأ عن ذلك من الفضول, التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم, وجميع ما على وجه الأرض, من أشجار ونباتات.
كل ذلك بانتظام وتدبير, وتسخير, تنبهر له العقول, وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول, ما يدل ذلك على قدرة مصرفها, وعلمه وحكمته, ورحمته الواسعة, ولطفه الشامل, وتصريفه وتدبيره, الذي تفرد به, وعظمته, وعظمة ملكه وسلطانه, مما يوجب أن يؤله ويعبد, ويفرد بالمحبة والتعظيم, والخوف والرجاء, وبذل الجهد في محابه ومراضيه.
وفي " وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ " وهي السفن والمراكب ونحوها, مما ألهم الله عباده صنعتها, وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية, ما أقدرهم عليها.
ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح, التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال, والبضائع التي هي من منافع الناس, وبما تقوم به مصالحهم وتنتظم معايشهم.
فمن الذي ألهمهم صنعتها, وأقدرهم عليها, وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟.
أم من الذي سخر لها البحر, تجري فيه بإذنه وتسخيره, والرياح؟.
أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية, النار والمعادن المعينة على حملها, وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه الأمور, حصلت اتفاقا, أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز, الذي خرج من بطن أمه, لا علم له ولا قدرة؟ ثم خلق له ربه القدرة, وعلمه ما يشاء تعليمه؟ أم المسخر لذلك رب واحد, حكيم عليم, لا يعجزه شيء, ولا يمتنع عليه شيء؟ بل الأشياء قد دانت بربوبيته, واستكانت لعظمته, وخضعت لجبروته؟ وغاية العبد الضعيف, أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب, التي بها وجدت هذه الأمور العظام, فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه, وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له, والخوف والرجاء, وجميع الطاعة, والذل والتعظيم.
" وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ " وهو المطر النازل من السحاب.
" فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا " فأظهرت من أنواع الأقوات, وأصناف النباتات, ما هو من ضرورات الخلائق, التي لا يعيشون بدونها.
أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله, وأخرج به ما أخرج ورحمته, ولطفه بعباده, وقيامه بمصالحهم, وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلا على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟ " وَبَثَّ فِيهَا " أي: في الأرض " مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ " أي: نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة, ما هو دليل على قدرته وعظمته, ووحدانيته وسلطانه العظيم.
وسخرها للناس, ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع.
فمنها: ما يأكلون من لحمه, ويشربون من دره.
ومنها: ما يركبون.
ومنها: ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم, ومنها ما يعتبر به.
ومنها: أنه بث فيها من كل دابة.
فإنه سبحانه, هو القائم بأرزاقهم, المتكفل بأقواتهم.
فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها, ويعلم مستقرها ومستودعها وفي " وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ " باردة وحارة, وجنوبا وشمالا, وشرقا ودبورا وبين ذلك.
وتارة تثير السحاب, وتارة تؤلف بينه, وتارة تلقحه, وتارة تدره, وتارة تمزقه وتزيل ضرره, وتارة تكون رحمة, وتارة ترسل بالعذاب.
فمن الذي صرفها هذا التصريف, وأودع فيها من منافع العباد, ما لا يستغنون عنه؟ وسخرها, ليعيش فيها جميع الحيوانات, وتصلح الأبدان والأشجار, والحبوب والنباتات, إلا العزيز الحكيم الرحيم, اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع, ومحبة وإنابة وعبادة؟ وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض - على خفته ولطافته - يحمل الماء الكثير, فيسوقه الله إلى حيث شاء.
فيحيي به البلاد والعباد, ويروي التلول والوهاد, وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه.
فإذا كان يضرهم كثرته, أمسكه عنهم, فينزله رحمة ولطفا, ويصرفه عناية وعطفا.
فما أعظم سلطانه, وأغزر إحسانه, وألطف امتنانه!! أليس من القبيح بالعباد, أن يتمتعوا برزقه, ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه.
أليس ذلك دليلا على حلمه وصبره, وعفوه وصفحه, وعظيم لطفه؟ فله الحمد أولا وآخرا, وباطنا وظاهرا.
والحاصل, أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات, وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات, وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة, علم بذلك, أنها خلقت للحق وبالحق, وأنها صحائف آيات, وكتب دلالات, على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته, وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر, وأنها مسخرات, ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها.
فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون, وإليه صامدون وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات.
فلا إله إلا الله, ولا رب سواه.
أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة, آيات أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته.
وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته.
ولكنها " لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ " أي: لمن لهم عقول يعملونها.
فيما خلقت له.
فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل, ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبيره.
ففي " خَلْقِ السَّمَاوَاتِ " في ارتفاعها واتساعها, وإحكامها, وإتقانها, وما جعل الله فيها من الشمس والقمر, والنجوم, وتنظيمها لمصالح العباد.
وفي خلق " الْأَرْضِ " مهادا للخلق, يمكنهم القرار عليها, والانتفاع بما عليها, والاعتبار, ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير, وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها, وحكمته التي بها أتقنها, وأحسنها ونظمها, وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع, من منافع الخلق ومصالحهم, وضروراتهم وحاجاتهم.
وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله, واستحقاقه أن يفرد بالعبادة, لانفراده بالخلق والتدبير, والقيام بشئون عباده.
وفي " اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ " , وهو تعاقبهما على الدوام, إذا ذهب أحدهما, خلفه الآخر.
وفي اختلافهما في الحر, والبرد, والتوسط, وفي الطول, والقصر, والتوسط, وما ينشأ عن ذلك من الفضول, التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم, وجميع ما على وجه الأرض, من أشجار ونباتات.
كل ذلك بانتظام وتدبير, وتسخير, تنبهر له العقول, وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول, ما يدل ذلك على قدرة مصرفها, وعلمه وحكمته, ورحمته الواسعة, ولطفه الشامل, وتصريفه وتدبيره, الذي تفرد به, وعظمته, وعظمة ملكه وسلطانه, مما يوجب أن يؤله ويعبد, ويفرد بالمحبة والتعظيم, والخوف والرجاء, وبذل الجهد في محابه ومراضيه.
وفي " وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ " وهي السفن والمراكب ونحوها, مما ألهم الله عباده صنعتها, وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية, ما أقدرهم عليها.
ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح, التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال, والبضائع التي هي من منافع الناس, وبما تقوم به مصالحهم وتنتظم معايشهم.
فمن الذي ألهمهم صنعتها, وأقدرهم عليها, وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟.
أم من الذي سخر لها البحر, تجري فيه بإذنه وتسخيره, والرياح؟.
أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية, النار والمعادن المعينة على حملها, وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه الأمور, حصلت اتفاقا, أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز, الذي خرج من بطن أمه, لا علم له ولا قدرة؟ ثم خلق له ربه القدرة, وعلمه ما يشاء تعليمه؟ أم المسخر لذلك رب واحد, حكيم عليم, لا يعجزه شيء, ولا يمتنع عليه شيء؟ بل الأشياء قد دانت بربوبيته, واستكانت لعظمته, وخضعت لجبروته؟ وغاية العبد الضعيف, أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب, التي بها وجدت هذه الأمور العظام, فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه, وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له, والخوف والرجاء, وجميع الطاعة, والذل والتعظيم.
" وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ " وهو المطر النازل من السحاب.
" فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا " فأظهرت من أنواع الأقوات, وأصناف النباتات, ما هو من ضرورات الخلائق, التي لا يعيشون بدونها.
أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله, وأخرج به ما أخرج ورحمته, ولطفه بعباده, وقيامه بمصالحهم, وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلا على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟ " وَبَثَّ فِيهَا " أي: في الأرض " مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ " أي: نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة, ما هو دليل على قدرته وعظمته, ووحدانيته وسلطانه العظيم.
وسخرها للناس, ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع.
فمنها: ما يأكلون من لحمه, ويشربون من دره.
ومنها: ما يركبون.
ومنها: ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم, ومنها ما يعتبر به.
ومنها: أنه بث فيها من كل دابة.
فإنه سبحانه, هو القائم بأرزاقهم, المتكفل بأقواتهم.
فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها, ويعلم مستقرها ومستودعها وفي " وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ " باردة وحارة, وجنوبا وشمالا, وشرقا ودبورا وبين ذلك.
وتارة تثير السحاب, وتارة تؤلف بينه, وتارة تلقحه, وتارة تدره, وتارة تمزقه وتزيل ضرره, وتارة تكون رحمة, وتارة ترسل بالعذاب.
فمن الذي صرفها هذا التصريف, وأودع فيها من منافع العباد, ما لا يستغنون عنه؟ وسخرها, ليعيش فيها جميع الحيوانات, وتصلح الأبدان والأشجار, والحبوب والنباتات, إلا العزيز الحكيم الرحيم, اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع, ومحبة وإنابة وعبادة؟ وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض - على خفته ولطافته - يحمل الماء الكثير, فيسوقه الله إلى حيث شاء.
فيحيي به البلاد والعباد, ويروي التلول والوهاد, وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه.
فإذا كان يضرهم كثرته, أمسكه عنهم, فينزله رحمة ولطفا, ويصرفه عناية وعطفا.
فما أعظم سلطانه, وأغزر إحسانه, وألطف امتنانه!! أليس من القبيح بالعباد, أن يتمتعوا برزقه, ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه.
أليس ذلك دليلا على حلمه وصبره, وعفوه وصفحه, وعظيم لطفه؟ فله الحمد أولا وآخرا, وباطنا وظاهرا.
والحاصل, أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات, وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات, وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة, علم بذلك, أنها خلقت للحق وبالحق, وأنها صحائف آيات, وكتب دلالات, على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته, وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر, وأنها مسخرات, ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها.
فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون, وإليه صامدون وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات.
فلا إله إلا الله, ولا رب سواه.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ↓
↓
 ↓
↓ثم قال تعالى " وَمِنَ النَّاسِ " إلى " وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ " .
ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي قبلها.
فإنه تعالى, لما بين وحدانيته وأداتها القاطعة, وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين, المزيلة لكل شك.
ذكر هنا أن " مِنَ النَّاسِ " مع هذا البيان التام " مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا " لله أي: نظراء ومثلاء, يساويهم في الله بالعبادة والمحبة, والتعظيم والطاعة.
ومن كان بهذه الحالة - بعد إقامة الحجة, وبيان التوحيد - علم أنه معاند لله, مشاق له, أو معرض عن تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته, فليس له أدنى عذر في ذلك, بل قد حقت عليه كلمة العذاب.
وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله, لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير, وإنما يسوونهم به, في العبادة, فيعبدونهم ليقربوهم إليه.
وفي قوله " اتخذوا " دليل على أنه ليس لله ند.
وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له, تسمية مجردة, ولفظا فارغا من المعنى.
كما قال تعالى.
" وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ " .
" إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ " .
فالمخلوق ليس ندا لله لأن الله هو الخالق, وغيره مخلوق, والرب هو الرازق.
ومن عداه مرزوق, والله هو الغني وأنتم الفقراء.
وهو الكامل من كل الوجوه, والعبيد ناقصون من جميع الوجوه.
والله هو النافع الضار, والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء.
فعلم علما يقينا, بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادا.
سواء كان ملكا أو نبيا, أو صالحا, صنما, أو غير ذلك.
وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة, والذل التام.
فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله " وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ " أي: من أهل الأنداد لأندادهم, لأنهم أخلصلوا محبتهم له, وهؤلاء أشركوا بها.
ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة, الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه.
والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئا, ومحبته عين شقاء العبد وفساده, وتشتت أمره.
فلهذا توعدهم الله بقوله.
" وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا " باتخاد الأنداد والانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله, وسعيهم فيما يضرهم.
" إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ " أي: يوم القيامة عيانا بأبصارهم.
" أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ " , أي: لعلموا علما جازما, أن القوة والقدرة لله كلها, وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء.
فتبين لهم في ذلك في اليوم, ضعفها وعجزها, لا كما اشتبه عليهم في الدنيا, وظنوا أن لها من الأمر شيئا, وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه.
فخاب ظنهم, وبطل سعيهم, وحق عليهم شدة العذاب, ولم تدفع عنهم أندادهم شيئا, ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع.
بل يحصل لهم الضرر منها, من حيث ظنوا نفعها.
ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي قبلها.
فإنه تعالى, لما بين وحدانيته وأداتها القاطعة, وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين, المزيلة لكل شك.
ذكر هنا أن " مِنَ النَّاسِ " مع هذا البيان التام " مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا " لله أي: نظراء ومثلاء, يساويهم في الله بالعبادة والمحبة, والتعظيم والطاعة.
ومن كان بهذه الحالة - بعد إقامة الحجة, وبيان التوحيد - علم أنه معاند لله, مشاق له, أو معرض عن تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته, فليس له أدنى عذر في ذلك, بل قد حقت عليه كلمة العذاب.
وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله, لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير, وإنما يسوونهم به, في العبادة, فيعبدونهم ليقربوهم إليه.
وفي قوله " اتخذوا " دليل على أنه ليس لله ند.
وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له, تسمية مجردة, ولفظا فارغا من المعنى.
كما قال تعالى.
" وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ " .
" إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ " .
فالمخلوق ليس ندا لله لأن الله هو الخالق, وغيره مخلوق, والرب هو الرازق.
ومن عداه مرزوق, والله هو الغني وأنتم الفقراء.
وهو الكامل من كل الوجوه, والعبيد ناقصون من جميع الوجوه.
والله هو النافع الضار, والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء.
فعلم علما يقينا, بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادا.
سواء كان ملكا أو نبيا, أو صالحا, صنما, أو غير ذلك.
وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة, والذل التام.
فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله " وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ " أي: من أهل الأنداد لأندادهم, لأنهم أخلصلوا محبتهم له, وهؤلاء أشركوا بها.
ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة, الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه.
والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئا, ومحبته عين شقاء العبد وفساده, وتشتت أمره.
فلهذا توعدهم الله بقوله.
" وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا " باتخاد الأنداد والانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله, وسعيهم فيما يضرهم.
" إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ " أي: يوم القيامة عيانا بأبصارهم.
" أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ " , أي: لعلموا علما جازما, أن القوة والقدرة لله كلها, وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء.
فتبين لهم في ذلك في اليوم, ضعفها وعجزها, لا كما اشتبه عليهم في الدنيا, وظنوا أن لها من الأمر شيئا, وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه.
فخاب ظنهم, وبطل سعيهم, وحق عليهم شدة العذاب, ولم تدفع عنهم أندادهم شيئا, ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع.
بل يحصل لهم الضرر منها, من حيث ظنوا نفعها.
إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ↓
↓
 ↓
↓وتبرأ المتبعون من التابعين, وتقطعت بينهم الوصل, التي كانت في الدنيا, لأنها كانت لغير الله, وعلى غير أمر الله, ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له, فاضمحلت أعمالهم, وتلاشت أحوالهم.
وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين, وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها, انقلبت عليهم حسرة وندامة, وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا.
فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل, ورجوا غير مرجو, وتعلقوا بغير متعلق, فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها.
ولما بطلت, وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيها, فضرتهم غاية الضرر.
وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين, وأخلص العمل لوجهه, ورجا نفعه.
فهذا قد وضع الحق في موضعه, فكانت أعماله حقا, لتعلقها بالحق, ففاز بنتيجة عمله, ووجد جزاءه عند ربه, غير منقطع كما قال تعالى.
" الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ " .
وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين, وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها, انقلبت عليهم حسرة وندامة, وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا.
فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل, ورجوا غير مرجو, وتعلقوا بغير متعلق, فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها.
ولما بطلت, وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيها, فضرتهم غاية الضرر.
وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين, وأخلص العمل لوجهه, ورجا نفعه.
فهذا قد وضع الحق في موضعه, فكانت أعماله حقا, لتعلقها بالحق, ففاز بنتيجة عمله, ووجد جزاءه عند ربه, غير منقطع كما قال تعالى.
" الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ " .
وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ↓
↓
 ↓
↓وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعيهم, بأن يتركوا الشرك بالله, ويقبلوا على إخلاص العمل لله.
وهيهات, فات الأمر, وليس الوقت وقت إمهال وإنظار.
ومع هذا, فهم كذبة, فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.
وإنما هو قول يقولونه, وأماني يتمنونها, حنقا وغيظا على المتبوعين لما تبرأوا منهم والذنب ذنبهم.
فرأس المتبوعين على الشر, إبليس, ومع هذا يقول لأتباعه.
" لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ " .
وهيهات, فات الأمر, وليس الوقت وقت إمهال وإنظار.
ومع هذا, فهم كذبة, فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.
وإنما هو قول يقولونه, وأماني يتمنونها, حنقا وغيظا على المتبوعين لما تبرأوا منهم والذنب ذنبهم.
فرأس المتبوعين على الشر, إبليس, ومع هذا يقول لأتباعه.
" لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ " .
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ↓
↓
 ↓
↓هذا خطاب للناس كلهم, مؤمنهم وكافرهم.
[فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب, وثمار, وفواكه, وحيوانات, حالة كونها " حَلَالًا " .
أي: محللا لكم تناوله.
ليس بغصب ولا سرقة, ولا محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معينا على محرم.
" طَيِّبًا " أي ليس: بخبيث, كالميتة والدم, ولحم الخنزير, والخبائث كلها.
ففي هذه الآية, دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة.
أكلا وانتفاعا, وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته, وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب.
وإما محرم لما عرض له, وهو المحرم لتعلق حق الله, أو حق عباده به, وهو ضد الحلال.
وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب, يأثم تاركه لظاهر الأمر.
ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به.
إذ هو عين صلاحهم, نهاهم عن اتباع " خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ " أي: طرقه التي يأمر بها, وهي جميع العاصى, من كفر, وفسوق, وظلم.
[ويدخل في ذلك تحريم السوائب, والحام, ونحو ذلك.
ويدخل فيه تناول المأكولات المحرمة.
" إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ " أي: ظاهر العداوة, فلا يريد بأمركم, إلا غشكم, وأن تكونوا من أصحاب السعير.
فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته, حتى أخبرنا - وهو أصدق القائلين - بعداوته الداعية للحذر منه, ثم لم يكتف بذلك, حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به, وأنه أقبح الأشياء, وأعظمها مفسدة فقال:
[فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب, وثمار, وفواكه, وحيوانات, حالة كونها " حَلَالًا " .
أي: محللا لكم تناوله.
ليس بغصب ولا سرقة, ولا محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معينا على محرم.
" طَيِّبًا " أي ليس: بخبيث, كالميتة والدم, ولحم الخنزير, والخبائث كلها.
ففي هذه الآية, دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة.
أكلا وانتفاعا, وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته, وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب.
وإما محرم لما عرض له, وهو المحرم لتعلق حق الله, أو حق عباده به, وهو ضد الحلال.
وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب, يأثم تاركه لظاهر الأمر.
ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به.
إذ هو عين صلاحهم, نهاهم عن اتباع " خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ " أي: طرقه التي يأمر بها, وهي جميع العاصى, من كفر, وفسوق, وظلم.
[ويدخل في ذلك تحريم السوائب, والحام, ونحو ذلك.
ويدخل فيه تناول المأكولات المحرمة.
" إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ " أي: ظاهر العداوة, فلا يريد بأمركم, إلا غشكم, وأن تكونوا من أصحاب السعير.
فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته, حتى أخبرنا - وهو أصدق القائلين - بعداوته الداعية للحذر منه, ثم لم يكتف بذلك, حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به, وأنه أقبح الأشياء, وأعظمها مفسدة فقال:
" إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ " أي: الشر الذي يسوء صاحبه, فيدخل في ذلك, جميع المعاصي.
فيكون قوله: " وَالْفَحْشَاءِ " من باب عطف الخاص على العام, لأن الفحشاء من المعاصي, ما تناهى قبحه, كالزنا, وشرب الخمر, والقتل, والقذف, والبخل ونحو ذلك, مما يستفحشه من له عقل.
" وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ " فيدخل في ذلك, القول على الله بلا علم, في شرعه, وقدره.
فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه, أو وصفه به رسوله, أو نفى عنه ما أثبته لنفسه, أو أثبت له ما نفاه عن نفسه, فقد قال على الله بلا علم.
ومن زعم أن لله ندا, وأوثانا, تقرب من عبدها من الله, فقد قال على الله تعالى بلا علم.
ومن قال: إن الله أحل كذا, أو حرم كذا, أو أمر بكذا, أو نهى عن كذا, بغير بصيرة, فقد قال على الله بلا علم.
ومن قال: الله خلق هذا الصنف من المخلوقات, للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك, فقد قال على الله بلا علم.
ومن أعظم القول على الله بلا علم, أن يتأول المتأول كلامه, أو كلام رسوله, على معاني اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال, ثم يقول: إن الله أرادها.
فالقول على الله بلا علم, من أكبر المحرمات, وأشملها, وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها, فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده, ويبذلون مكرهم وخداعهم, على إغواء الخلق بما يقدرون عليه.
وأما الله تعالى, فإنه يأمر بالعدل والإحسان, وإيتاء ذي القربى, وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي.
فلينظر العبد نفسه, مع أي الداعيين, ومن أي الحزبين؟
فيكون قوله: " وَالْفَحْشَاءِ " من باب عطف الخاص على العام, لأن الفحشاء من المعاصي, ما تناهى قبحه, كالزنا, وشرب الخمر, والقتل, والقذف, والبخل ونحو ذلك, مما يستفحشه من له عقل.
" وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ " فيدخل في ذلك, القول على الله بلا علم, في شرعه, وقدره.
فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه, أو وصفه به رسوله, أو نفى عنه ما أثبته لنفسه, أو أثبت له ما نفاه عن نفسه, فقد قال على الله بلا علم.
ومن زعم أن لله ندا, وأوثانا, تقرب من عبدها من الله, فقد قال على الله تعالى بلا علم.
ومن قال: إن الله أحل كذا, أو حرم كذا, أو أمر بكذا, أو نهى عن كذا, بغير بصيرة, فقد قال على الله بلا علم.
ومن قال: الله خلق هذا الصنف من المخلوقات, للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك, فقد قال على الله بلا علم.
ومن أعظم القول على الله بلا علم, أن يتأول المتأول كلامه, أو كلام رسوله, على معاني اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال, ثم يقول: إن الله أرادها.
فالقول على الله بلا علم, من أكبر المحرمات, وأشملها, وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها, فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده, ويبذلون مكرهم وخداعهم, على إغواء الخلق بما يقدرون عليه.
وأما الله تعالى, فإنه يأمر بالعدل والإحسان, وإيتاء ذي القربى, وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي.
فلينظر العبد نفسه, مع أي الداعيين, ومن أي الحزبين؟
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ ↓
↓
 ↓
↓أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية, الذي كل الفلاح بطاعته, وكل الفوز في خدمته, وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة, الذي لا يأمر إلا بالخير, ولا ينهى إلا عن الشر.
أم تتبع داعي الشيطان, الذي هو عدو الإنسان, الذي يريد لك الشر, ويسعى - بجهده - على إهلاكك في الدنيا والآخرة.
الذي كل الشر في طاعته, وكل الخسران في ولايته.
والذي لا يأمر إلا بشر, ولا ينهى إلا عن خير.
ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله, مما تقدم وصفه, رغبوا عن ذلك وقالوا.
" بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا " .
فاكتفوا بتقليد الآباء, وزهدوا في الإيمان بالأنبياء.
ومع هذا, فآباؤهم أجهل الناس, وأشدهم ضلالا وهذه شبهة لرد الحق, واهية.
فهذا دليل على إعراضهم عن الحق, ورغبتهم عنه, وعدم إنصافهم.
فلو هدوا, لرشدهم, وحسن قصدهم, لكان الحق هو القصد.
ومن جعل الحق قصده, ووازن بينه وبين غيره, تبين له الحق قطعا, واتبعه, إن كان منصفا.
أم تتبع داعي الشيطان, الذي هو عدو الإنسان, الذي يريد لك الشر, ويسعى - بجهده - على إهلاكك في الدنيا والآخرة.
الذي كل الشر في طاعته, وكل الخسران في ولايته.
والذي لا يأمر إلا بشر, ولا ينهى إلا عن خير.
ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله, مما تقدم وصفه, رغبوا عن ذلك وقالوا.
" بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا " .
فاكتفوا بتقليد الآباء, وزهدوا في الإيمان بالأنبياء.
ومع هذا, فآباؤهم أجهل الناس, وأشدهم ضلالا وهذه شبهة لرد الحق, واهية.
فهذا دليل على إعراضهم عن الحق, ورغبتهم عنه, وعدم إنصافهم.
فلو هدوا, لرشدهم, وحسن قصدهم, لكان الحق هو القصد.
ومن جعل الحق قصده, ووازن بينه وبين غيره, تبين له الحق قطعا, واتبعه, إن كان منصفا.
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ↓
↓
 ↓
↓ثم قال تعالى " وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ " .
لما بين تعالى, عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل, وردهم لذلك, بالتقليد, وعلم من ذلك أنهم غير قابلين للحق, ولا مستجيبين له, بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم - أخبر تعالى, أن مثلهم - عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان - كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها, وليس لها علم بما يقول راعيها ومناديها.
فهم يسمعون مجرد الصوت, الذي تقوم به عليهم الحجة, ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم, فلهذا كانوا صما, لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول, عميا, لا ينظرون نظر اعتبار, بكما, فلا ينطقون بما فيه خير لهم.
والسبب الموجب لذلك كله, أنه ليس لهم عقل صحيح, بل هم أسفه السفهاء, وأجهل الجهلاء.
فهل يستريب العاقل, أن من دعى إلى الرشاد, وذيد عن الفساد, ونهى عن اقتحام العذاب, وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه, وفوزه, ونعيمه فعصى الناصح, وتولى عن أمر ربه, واقتحم النار على بصيرة, واتبع الباطل, ونبذ الحق - أن هذا ليس له مسكة من عقل, وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء, فإنه من أسفه السفهاء.
لما بين تعالى, عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل, وردهم لذلك, بالتقليد, وعلم من ذلك أنهم غير قابلين للحق, ولا مستجيبين له, بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم - أخبر تعالى, أن مثلهم - عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان - كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها, وليس لها علم بما يقول راعيها ومناديها.
فهم يسمعون مجرد الصوت, الذي تقوم به عليهم الحجة, ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم, فلهذا كانوا صما, لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول, عميا, لا ينظرون نظر اعتبار, بكما, فلا ينطقون بما فيه خير لهم.
والسبب الموجب لذلك كله, أنه ليس لهم عقل صحيح, بل هم أسفه السفهاء, وأجهل الجهلاء.
فهل يستريب العاقل, أن من دعى إلى الرشاد, وذيد عن الفساد, ونهى عن اقتحام العذاب, وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه, وفوزه, ونعيمه فعصى الناصح, وتولى عن أمر ربه, واقتحم النار على بصيرة, واتبع الباطل, ونبذ الحق - أن هذا ليس له مسكة من عقل, وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء, فإنه من أسفه السفهاء.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ↓
↓
 ↓
↓هذا أمر للمؤمنين خاصة, بعد الأمر العام, وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة - بالأوامر والنواهي, بسبب إيمانهم, فأمرهم بأمر الطيبات من الرزق, والشكر لله على إنعامه, باستعمالها بطاعتة, والتقوى بها على ما يوصل إليه.
فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله " يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا " .
فالشكر في هذه الآية, هو العمل الصالح.
وهنا لم يقل " حلالا " لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق, خالصة من التبعة.
ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له.
وقوله " إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ " أي: فاشكروه.
فدل على أن من لم يشكر الله, لم يعبده وحده, كما أن من شكره, فقد عبده, وأتى بما أمر به.
ويدل أيضا على أن أكل الطيب, سبب للعمل الصالح وقبوله.
والأمر بالشكر, عقيب النعم, لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة, ويجلب النعم المفقودة.
كما أن الكفر, ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة.
فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله " يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا " .
فالشكر في هذه الآية, هو العمل الصالح.
وهنا لم يقل " حلالا " لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق, خالصة من التبعة.
ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له.
وقوله " إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ " أي: فاشكروه.
فدل على أن من لم يشكر الله, لم يعبده وحده, كما أن من شكره, فقد عبده, وأتى بما أمر به.
ويدل أيضا على أن أكل الطيب, سبب للعمل الصالح وقبوله.
والأمر بالشكر, عقيب النعم, لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة, ويجلب النعم المفقودة.
كما أن الكفر, ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة.
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ↓
↓
 ↓
↓ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال " إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ " وهي: ما مات بغير تذكية شرعية, لأن الميتة خبيثة مضرة, لرداءتها في نفسها, ولأن الأغلب, أن تكون عن مرض, فيكون زيادة مرض.
واستثنى الشارع من هذا العموم, ميتة الجراد, وسمك البحر, فإنه حلال طيب.
" وَالدَّمَ " أي: المسفوح كما قيد في الآية الأخرى.
" وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ " أي: ذبح لغير الله, كالذي يذبح للأصنام والأوثان, من الأحجار, والقبور ونحوها, وهذا المذكور غير خاص للمحرمات.
وجيء به, لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله " طَيِّبَاتِ " .
فعموم المحرمات, تستفاد من الآية السابقة, من قوله: " حَلَالًا طَيِّبًا " كما تقدم.
وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها, لطفا بنا, وتنزيها عن المضر.
ومع هذا " فَمَنِ اضْطُرَّ " أي: ألجئ إلى المحرم, بجوع وعدم, وإكراه.
" غَيْرَ بَاغٍ " أي: غير طالب للمحرم, مع قدرته على الحلال, أو مع عدم جوعه.
" وَلَا عَادٍ " أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له, اضطرارا.
" فَلَا إِثْمَ " أي: جناح وذنب " عَلَيْهِ " .
وإذا ارتفع الإثم, رجع الأمر إلى ما كان عليه.
والإنسان بهذه الحالة, مأمور بالأكل, بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة, وأن يقتل نفسه.
فيجب, إذا, عليه الأكل, ويأثم إن ترك الأكل حتى مات, فيكون قاتلا لنفسه.
وهذه الإباحة والتوسعة, من رحمته تعالى بعباده, فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: " إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " .
ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين, وكان الإنسان في هذه الحالة, ربما لا يستقصى تمام الاستقصاء في تحقيقها - أخبر, أنه غفور, فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال, خصوصا وقد غلبته الضرورة, وأذهبت حواسه المشقة.
وفي هذه الآية, دليل على القاعدة المشهورة " الضرورات تبيح المحظورات " .
فكل محظور, اضطر إليه الإنسان, فقد أباحه له, الملك الرحمن.
فله الحمد والشكر, أولا وآخرا, وظاهرا وباطنا.
واستثنى الشارع من هذا العموم, ميتة الجراد, وسمك البحر, فإنه حلال طيب.
" وَالدَّمَ " أي: المسفوح كما قيد في الآية الأخرى.
" وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ " أي: ذبح لغير الله, كالذي يذبح للأصنام والأوثان, من الأحجار, والقبور ونحوها, وهذا المذكور غير خاص للمحرمات.
وجيء به, لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله " طَيِّبَاتِ " .
فعموم المحرمات, تستفاد من الآية السابقة, من قوله: " حَلَالًا طَيِّبًا " كما تقدم.
وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها, لطفا بنا, وتنزيها عن المضر.
ومع هذا " فَمَنِ اضْطُرَّ " أي: ألجئ إلى المحرم, بجوع وعدم, وإكراه.
" غَيْرَ بَاغٍ " أي: غير طالب للمحرم, مع قدرته على الحلال, أو مع عدم جوعه.
" وَلَا عَادٍ " أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له, اضطرارا.
" فَلَا إِثْمَ " أي: جناح وذنب " عَلَيْهِ " .
وإذا ارتفع الإثم, رجع الأمر إلى ما كان عليه.
والإنسان بهذه الحالة, مأمور بالأكل, بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة, وأن يقتل نفسه.
فيجب, إذا, عليه الأكل, ويأثم إن ترك الأكل حتى مات, فيكون قاتلا لنفسه.
وهذه الإباحة والتوسعة, من رحمته تعالى بعباده, فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: " إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " .
ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين, وكان الإنسان في هذه الحالة, ربما لا يستقصى تمام الاستقصاء في تحقيقها - أخبر, أنه غفور, فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال, خصوصا وقد غلبته الضرورة, وأذهبت حواسه المشقة.
وفي هذه الآية, دليل على القاعدة المشهورة " الضرورات تبيح المحظورات " .
فكل محظور, اضطر إليه الإنسان, فقد أباحه له, الملك الرحمن.
فله الحمد والشكر, أولا وآخرا, وظاهرا وباطنا.
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ↓
↓
 ↓
↓هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله, من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله, أن يبينوه للناس ولا يكتموه.
فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي, ونبذ أمر الله, فأولئك.
" مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ " , لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه, إنما حصل لهم بأقبح المكاسب, وأعظم المحرمات, فكان جزاؤهم من جنس عملهم.
" وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم.
فهذا أعظم عليهم من عذاب النار.
" وَلَا يُزَكِّيهِمْ " أي: لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة, وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها.
وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها, العمل بكتاب الله, والاهتداء به, والدعوة إليه.
فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي, ونبذ أمر الله, فأولئك.
" مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ " , لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه, إنما حصل لهم بأقبح المكاسب, وأعظم المحرمات, فكان جزاؤهم من جنس عملهم.
" وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم.
فهذا أعظم عليهم من عذاب النار.
" وَلَا يُزَكِّيهِمْ " أي: لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة, وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها.
وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها, العمل بكتاب الله, والاهتداء به, والدعوة إليه.
أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ↓
↓
 ↓
↓فهؤلاء نبذوا كتاب الله, وأعرضوا عنه, واختاروا الضلالة على الهدى, والعذاب على المغفرة.
فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار, فكيف يصبرون عليها, وأنى لهم الجلد عليها؟!!
فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار, فكيف يصبرون عليها, وأنى لهم الجلد عليها؟!!
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ↓
↓
 ↓
↓" ذَلِكَ " المذكور, وهو مجازاته بالعدل, ومنعه أسباب الهداية, ممن أباها واختار سواها.
" بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ " ومن الحق, مجازاة المحسن بإحسانه, والمسيء بإساءته.
وأيضا ففي قوله: " نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ " ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه, وتبيين الحق من الباطل, والهدى من الضلال.
فمن صرفه عن مقصوده, فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة.
" وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ " أي: وإن الذين اختلفوا في الكتاب, فآمنوا ببعضه, وكفروا ببعضه.
والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم " لَفِي شِقَاقٍ " أي: محادة.
" بَعِيدٍ " من الحق لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض.
فمرج أمرهم, وكثر شقاقهم, وترتب على ذلك افتراقهم.
بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به, وحكموه في كل شيء, فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه.
وقد تضمنت هذه الآيات, الوعيد للكاتمين لما أنزل الله, المؤثرين عليه, عرض الدنيا - بالعذاب والسخط, وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق, ولا بالمغفرة.
وذكر السبب في ذلك وهو إيثارهم الضلالة على الهدى.
فترتب على ذلك, اختيار العذاب على المغفرة.
ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار, لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة إليها.
وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه, وعلم الافتراق.
وأن كل من خالفه, فهو في غاية البعد عن الحق, والمنازعة والمخاصمة, والله أعلم.
" بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ " ومن الحق, مجازاة المحسن بإحسانه, والمسيء بإساءته.
وأيضا ففي قوله: " نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ " ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه, وتبيين الحق من الباطل, والهدى من الضلال.
فمن صرفه عن مقصوده, فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة.
" وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ " أي: وإن الذين اختلفوا في الكتاب, فآمنوا ببعضه, وكفروا ببعضه.
والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم " لَفِي شِقَاقٍ " أي: محادة.
" بَعِيدٍ " من الحق لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض.
فمرج أمرهم, وكثر شقاقهم, وترتب على ذلك افتراقهم.
بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به, وحكموه في كل شيء, فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه.
وقد تضمنت هذه الآيات, الوعيد للكاتمين لما أنزل الله, المؤثرين عليه, عرض الدنيا - بالعذاب والسخط, وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق, ولا بالمغفرة.
وذكر السبب في ذلك وهو إيثارهم الضلالة على الهدى.
فترتب على ذلك, اختيار العذاب على المغفرة.
ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار, لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة إليها.
وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه, وعلم الافتراق.
وأن كل من خالفه, فهو في غاية البعد عن الحق, والمنازعة والمخاصمة, والله أعلم.
لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ↓
↓
 ↓
↓يقول تعالى: " لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ " أي: ليس هذا هو البر المقصود من العباد, فيكون كثرة البحث فيه والجدال, من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف.
وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم " ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب " ونحو ذلك.
" وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ " أي: بإنه إله واحد, موصوف بكل صفة كمال, منزه عن كل نقص.
" وَالْيَوْمِ الْآخِرِ " وهو كل ما أخبر الله به في كتابه, أو أخبر به الرسول, مما يكون بعد الموت.
" وَالْمَلَائِكَةِ " الذين وصفهم الله لنا في كتابه, ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم.
" وَالْكِتَابِ " أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على رسوله, وأعظمها القرآن, فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام.
" وَالنَّبِيِّينَ " عموما, خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم " وَآتَى الْمَالَ " وهو كل ما يتموله الإنسان من مال, قليلا كان أو كثيرا.
أي: أعطى المال " عَلَى حُبِّهِ " أي: حب المال " عَلَى حُبِّهِ " أي: حب المال.
بين به أن المال محبوب للنفوس, فلا يكاد يخرجه العبد.
فمن أخرجه مع حبه له, تقربا إلى الله تعالى, كان هذا برهانا لإيمانه.
ومن إيتاء المال على حبه, أن يتصدق وهو صحيح شحيح, يأمل الغنى, ويخشى الفقر.
وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة, كان أفضل, لأنه في هذه الحال, يحب إمساكه, لما يتوهمه من العدم والفقر.
وكذلك إخراج النفيس من المال, وما يحبه من ماله كما قال تعالى: " لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ " .
فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه.
ثم ذكر المنفق عليهم, وهم أولى الناس ببرك وإحسانك.
من " ذَوِي الْقُرْبَى " الذين تتوجع لمصابهم, وتفرح بسرورهم, الذين يتناصرون ويتعاقلون.
فمن أحسن البر وأوفقه, تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي, على حسب قربهم وحاجتهم.
" وَالْيَتَامَى " الذين لا كاسب لهم, وليس لهم قوة يستغنون بها.
وهذا من رحمته تعالى بالعباد, الدالة على أنه تعالى, أرحم بهم من الوالد بولده.
فالله قد أوصى العباد, وفرض عليهم في أموالهم, الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه.
ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم يتيم غيره, رحمه يتيمه.
" وَالْمَسَاكِينِ " وهم الذين أسكنتهم الحاجة, وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء, بما يدفع مسكنتهم أو يخففها, بما يقدرون عليه, وبما يتيسر.
" وَابْنَ السَّبِيلِ " وهو الغريب المنقطع به في غير بلده.
فحث الله عباده على إعطائه من المال, ما يعينه غلى سفره, لكونه مظنة الحاجة, وكثرة المصارف.
فعلى من أنعم الله
عليه بوطنه وراحته, وخوله من نعمته, أن يرحم أخاه الغريب, الذي بهذه الصفة, على حسب استطاعته, ولو بتزويده, أو إعطائه آلة لسفره, أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها.
" وَالسَّائِلِينَ " أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج, توجب السؤال.
كمن ابتلي بأرش جناية, أو ضريبة عليه من ولاة الأمور, أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة, كالمساجد, والمدارس, والقناطر, ونحو ذلك, فهذا له الحق, وإن كان غنيا " وَفِي الرِّقَابِ " فيدخل فيه العتق والإعانة عليه, وبذل مال للمكاتب, ليوفي سيده, وفداء الأسرى عند الكفار, أو عند الظلمة.
" وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ " قد تقدم مرارا, أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة, لكونهما أفضل العبادات, وأكمل القربات, عبادات قلبية, وبدنية, ومالية, وبهما يوزن الإيمان, ويعرف ما مع صاحبه من الإيقاق.
" وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا " والعهد, هو, الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه.
فدخل في ذلك حقوق الله كلها, لكون الله ألزم بها عباده والتزموها, ودخلوا تحت عهدتها, ووجب عليهم أداؤها, وحقوق العباد, التي أوجبها الله عليهم, والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور, ونحو ذلك.
" وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ " أي: الفقر, لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة, لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة, ما لا يحصل لغيره.
فإن تنعم الأغنياء, بما لا يقدر عليه, تألم.
وإن جاع, أو جاعت عياله, تألم.
وإن أكل طعاما, غير موافق لهواه, تألم.
وإن عرى, أو كاد, تألم, وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم, وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه, تألم.
فكل هذه ونحوها, مصائب, يؤمر بالصبر عليها, والاحتساب, ورجاء الثواب من الله عليها.
" وَالضَّرَّاءِ " أي: المرض على اختلاف أنواعه, من حمى, وقروح, ورياح, ووجع عضو, حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك, فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك.
لأن النفس تضعف, والبدن, يألم, وذلك في غاية المشقة على النفوس, خصوصا مع تطاول ذلك, فإنه يؤمر بالصبر, احتسابا لثواب الله تعالى.
" وَحِينَ الْبَأْسِ " أي: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم, لأن الجلاد, يشق غاية المشقة على النفس, ويجزع الإنسان من القتل, أو الجراح, أو الأسر, فاحتيج إلى الصبر في ذلك, احتسابا, ورجاء لثواب الله تعالى, الذي منه النصر والمعونة, التي وعدها الصابرين.
" أُولَئِكَ " أي: المتصفون بما ذكر, من العقائد الحسنة, والأعمال التي هي آثار الإيمان, وبرهانه ونوره, والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية.
فأولئك " الَّذِينَ صَدَقُوا " في إيمانهم, لأن أعمالهم صدقت إيمانهم.
" وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ " لأنهم تركوا المحظور, وفعلوا المأمور.
لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير, تضمنا ولزوما, لأن الوفاء بالعهد, يدخل فيه الدين كله.
ومن قام بها, كان بما سواها أقوم, فهؤلاء الأبرار الصادقون المتقون.
وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة, من الثواب الدنيوي والأخروي, مما لا يمكن تفصيله في مثل هذا الموضع.
وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم " ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب " ونحو ذلك.
" وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ " أي: بإنه إله واحد, موصوف بكل صفة كمال, منزه عن كل نقص.
" وَالْيَوْمِ الْآخِرِ " وهو كل ما أخبر الله به في كتابه, أو أخبر به الرسول, مما يكون بعد الموت.
" وَالْمَلَائِكَةِ " الذين وصفهم الله لنا في كتابه, ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم.
" وَالْكِتَابِ " أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على رسوله, وأعظمها القرآن, فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام.
" وَالنَّبِيِّينَ " عموما, خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم " وَآتَى الْمَالَ " وهو كل ما يتموله الإنسان من مال, قليلا كان أو كثيرا.
أي: أعطى المال " عَلَى حُبِّهِ " أي: حب المال " عَلَى حُبِّهِ " أي: حب المال.
بين به أن المال محبوب للنفوس, فلا يكاد يخرجه العبد.
فمن أخرجه مع حبه له, تقربا إلى الله تعالى, كان هذا برهانا لإيمانه.
ومن إيتاء المال على حبه, أن يتصدق وهو صحيح شحيح, يأمل الغنى, ويخشى الفقر.
وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة, كان أفضل, لأنه في هذه الحال, يحب إمساكه, لما يتوهمه من العدم والفقر.
وكذلك إخراج النفيس من المال, وما يحبه من ماله كما قال تعالى: " لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ " .
فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه.
ثم ذكر المنفق عليهم, وهم أولى الناس ببرك وإحسانك.
من " ذَوِي الْقُرْبَى " الذين تتوجع لمصابهم, وتفرح بسرورهم, الذين يتناصرون ويتعاقلون.
فمن أحسن البر وأوفقه, تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي, على حسب قربهم وحاجتهم.
" وَالْيَتَامَى " الذين لا كاسب لهم, وليس لهم قوة يستغنون بها.
وهذا من رحمته تعالى بالعباد, الدالة على أنه تعالى, أرحم بهم من الوالد بولده.
فالله قد أوصى العباد, وفرض عليهم في أموالهم, الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه.
ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم يتيم غيره, رحمه يتيمه.
" وَالْمَسَاكِينِ " وهم الذين أسكنتهم الحاجة, وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء, بما يدفع مسكنتهم أو يخففها, بما يقدرون عليه, وبما يتيسر.
" وَابْنَ السَّبِيلِ " وهو الغريب المنقطع به في غير بلده.
فحث الله عباده على إعطائه من المال, ما يعينه غلى سفره, لكونه مظنة الحاجة, وكثرة المصارف.
فعلى من أنعم الله
عليه بوطنه وراحته, وخوله من نعمته, أن يرحم أخاه الغريب, الذي بهذه الصفة, على حسب استطاعته, ولو بتزويده, أو إعطائه آلة لسفره, أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها.
" وَالسَّائِلِينَ " أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج, توجب السؤال.
كمن ابتلي بأرش جناية, أو ضريبة عليه من ولاة الأمور, أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة, كالمساجد, والمدارس, والقناطر, ونحو ذلك, فهذا له الحق, وإن كان غنيا " وَفِي الرِّقَابِ " فيدخل فيه العتق والإعانة عليه, وبذل مال للمكاتب, ليوفي سيده, وفداء الأسرى عند الكفار, أو عند الظلمة.
" وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ " قد تقدم مرارا, أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة, لكونهما أفضل العبادات, وأكمل القربات, عبادات قلبية, وبدنية, ومالية, وبهما يوزن الإيمان, ويعرف ما مع صاحبه من الإيقاق.
" وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا " والعهد, هو, الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه.
فدخل في ذلك حقوق الله كلها, لكون الله ألزم بها عباده والتزموها, ودخلوا تحت عهدتها, ووجب عليهم أداؤها, وحقوق العباد, التي أوجبها الله عليهم, والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور, ونحو ذلك.
" وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ " أي: الفقر, لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة, لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة, ما لا يحصل لغيره.
فإن تنعم الأغنياء, بما لا يقدر عليه, تألم.
وإن جاع, أو جاعت عياله, تألم.
وإن أكل طعاما, غير موافق لهواه, تألم.
وإن عرى, أو كاد, تألم, وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم, وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه, تألم.
فكل هذه ونحوها, مصائب, يؤمر بالصبر عليها, والاحتساب, ورجاء الثواب من الله عليها.
" وَالضَّرَّاءِ " أي: المرض على اختلاف أنواعه, من حمى, وقروح, ورياح, ووجع عضو, حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك, فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك.
لأن النفس تضعف, والبدن, يألم, وذلك في غاية المشقة على النفوس, خصوصا مع تطاول ذلك, فإنه يؤمر بالصبر, احتسابا لثواب الله تعالى.
" وَحِينَ الْبَأْسِ " أي: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم, لأن الجلاد, يشق غاية المشقة على النفس, ويجزع الإنسان من القتل, أو الجراح, أو الأسر, فاحتيج إلى الصبر في ذلك, احتسابا, ورجاء لثواب الله تعالى, الذي منه النصر والمعونة, التي وعدها الصابرين.
" أُولَئِكَ " أي: المتصفون بما ذكر, من العقائد الحسنة, والأعمال التي هي آثار الإيمان, وبرهانه ونوره, والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية.
فأولئك " الَّذِينَ صَدَقُوا " في إيمانهم, لأن أعمالهم صدقت إيمانهم.
" وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ " لأنهم تركوا المحظور, وفعلوا المأمور.
لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير, تضمنا ولزوما, لأن الوفاء بالعهد, يدخل فيه الدين كله.
ومن قام بها, كان بما سواها أقوم, فهؤلاء الأبرار الصادقون المتقون.
وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة, من الثواب الدنيوي والأخروي, مما لا يمكن تفصيله في مثل هذا الموضع.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ↓
↓
 ↓
↓يمتن تعالى على عباده المؤمنين, بأنه فرض عليهم " الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى " أي: المساواة فيه, وأن يقتل القاتل على الصفة, التي قتل عليها المقتول, إقامة للعدل والقسط بين العباد وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين, فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه - إعانة ولي المقتول, إذا طلب القصاص ويمكنه من القاتل, وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد, ويمنعوا الولي من الاقتصاص, كما عليه عادة الجاهلية, ومن أشبههم من إيواء المحدثين.
ثم بين تفصيل ذلك فقال " الْحُرُّ بِالْحُرِّ " يدخل بمنطقوقها, الذكر بالذكر.
" وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى " والأنثى بالذكر, والذكر بالأنثى, فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله " الأنثى بالأنثى " مع دلالة السنة, على أن الذكر يقتل بالأنثى.
وخرج من عموم هذا, الأبوان وإن علوا.
فلا يقتلان بالولد, لورود السنة بذلك.
مع أن في قوله " الْقِصَاصُ " ما يدل على أنه ليس من العدل, أن يقتل الوالد بولده.
ولأن في قلب الوالد من الشفقة والرحمة, ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله, أو أذية شديدة جدا من الولد له.
وخرج من العموم أيضا, الكافر بالسنة, مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة.
وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه.
والعبد بالعبد, ذكرا كان أو أنثى, تساوت قيمتهما أو اختلفت.
ودل بمفهومها على أن الحر, لا يقتل بالعبد, لكونه غير مساو له.
والأنثى بالأنثى, أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة, وتقدم وجه ذلك.
وفي هذه الآية, دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل, وأن الدية بدل عنه.
فلهذا قال " فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ " أي عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية, أو عفا بعض
الألياء, فإنه يسقط القصاص, وتجب الدية, وتكون الخيرة في القود, واختيار الدية إلى الولي.
فإذا عفا عنه, وجب على الولي, أي: ولي المقتول أن يتبع القاتل " بِالْمَعْرُوفِ " من غير أن يشق عليه, ولا يحمله ما لا يطيق, بل يحسن الاقتضاء والطلب, ولا يحرجه.
وعلى القاتل " وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ " من غير مطل ولا نقص, ولا إساءة فعلية أو قولية, فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو, إلا الإحسان بحسن القضاء.
وهذا مأمور به في كل ما يثبت في ذمم الناس للإنسان.
مأمور من له الحق, بالاتباع بالمعروف.
ومن عليه الحق, بالأداء بالإحسان.
وفي قوله " فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ " ترقيق وحث على العفو إلى الدية.
وأحسن من ذلك, العفو مجانا.
وفي قوله " أَخِيهِ " دليل على أن القاتل, لا يكفر, لأن المراد بالأخوة هنا, أخوة الإيمان, فلم يخرج بالقتل منها.
ومن باب أولى, أن سائر المعاصي, التي هي دون الكفر, ولا يكفر بها فاعلها, وإنما ينقص بذلك إيمانه.
وإذا عفا أولياء المقتول, أو عفا بعضهم, احتقن دم القاتل, وصار معصوما منهم ومن غيرهم, ولهذا قال " فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ " أي: بعد العفو " فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ " أي: في الآخرة.
وأما قتله وعدمه, فيؤخذ مما تقدم, لأنه قتل مكافئا له, فيجب قتله بذلك.
وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل, وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله, ولا يجوز العفو عنه, وبذلك قال بعض العلماء.
والصحيح الأول, لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره.
ثم بين تفصيل ذلك فقال " الْحُرُّ بِالْحُرِّ " يدخل بمنطقوقها, الذكر بالذكر.
" وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى " والأنثى بالذكر, والذكر بالأنثى, فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله " الأنثى بالأنثى " مع دلالة السنة, على أن الذكر يقتل بالأنثى.
وخرج من عموم هذا, الأبوان وإن علوا.
فلا يقتلان بالولد, لورود السنة بذلك.
مع أن في قوله " الْقِصَاصُ " ما يدل على أنه ليس من العدل, أن يقتل الوالد بولده.
ولأن في قلب الوالد من الشفقة والرحمة, ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله, أو أذية شديدة جدا من الولد له.
وخرج من العموم أيضا, الكافر بالسنة, مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة.
وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه.
والعبد بالعبد, ذكرا كان أو أنثى, تساوت قيمتهما أو اختلفت.
ودل بمفهومها على أن الحر, لا يقتل بالعبد, لكونه غير مساو له.
والأنثى بالأنثى, أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة, وتقدم وجه ذلك.
وفي هذه الآية, دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل, وأن الدية بدل عنه.
فلهذا قال " فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ " أي عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية, أو عفا بعض
الألياء, فإنه يسقط القصاص, وتجب الدية, وتكون الخيرة في القود, واختيار الدية إلى الولي.
فإذا عفا عنه, وجب على الولي, أي: ولي المقتول أن يتبع القاتل " بِالْمَعْرُوفِ " من غير أن يشق عليه, ولا يحمله ما لا يطيق, بل يحسن الاقتضاء والطلب, ولا يحرجه.
وعلى القاتل " وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ " من غير مطل ولا نقص, ولا إساءة فعلية أو قولية, فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو, إلا الإحسان بحسن القضاء.
وهذا مأمور به في كل ما يثبت في ذمم الناس للإنسان.
مأمور من له الحق, بالاتباع بالمعروف.
ومن عليه الحق, بالأداء بالإحسان.
وفي قوله " فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ " ترقيق وحث على العفو إلى الدية.
وأحسن من ذلك, العفو مجانا.
وفي قوله " أَخِيهِ " دليل على أن القاتل, لا يكفر, لأن المراد بالأخوة هنا, أخوة الإيمان, فلم يخرج بالقتل منها.
ومن باب أولى, أن سائر المعاصي, التي هي دون الكفر, ولا يكفر بها فاعلها, وإنما ينقص بذلك إيمانه.
وإذا عفا أولياء المقتول, أو عفا بعضهم, احتقن دم القاتل, وصار معصوما منهم ومن غيرهم, ولهذا قال " فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ " أي: بعد العفو " فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ " أي: في الآخرة.
وأما قتله وعدمه, فيؤخذ مما تقدم, لأنه قتل مكافئا له, فيجب قتله بذلك.
وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل, وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله, ولا يجوز العفو عنه, وبذلك قال بعض العلماء.
والصحيح الأول, لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره.
ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ " أي: تنحقن بذلك الدماء, وتنقمع به الأشقياء, لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل, لا يكاد يصدر منه القتل, وإذا رؤي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره, وانزجر, فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل, لم يحصل انكفاف الشر, الذي يحصل بالقتل.
وهكذا سائر الحدود الشرعية, فيها من النكاية والانزجار, ما يدل على حكمة الحكيم الغفار.
ونكر " الحياة " لإفادة التعظيم والتكثير.
ولما كان هذا الحكم, لا يعرف حقيقته, إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة, خصهم بالخطاب دون غيرهم.
وهذا يدل على أن الله تعالى, يحب من عباده, أن يعملوا أفكارهم وعقولهم, في تدبر ما في أحكامه, من الحكم, والمصالح الدالة على كماله, وكمال حكمته وحمده, وعدله ورحمته الواسعة وأن من كان بهذه المثابة, فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب, وناداهم رب الأرباب, وكفى بذلك فضلا, وشرفا, لقوم يعقلون.
وقوله " لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة, أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله, ويعظم معاصيه, فيتركها, فيستحق بذلك أن يكون من المتقين.
وهكذا سائر الحدود الشرعية, فيها من النكاية والانزجار, ما يدل على حكمة الحكيم الغفار.
ونكر " الحياة " لإفادة التعظيم والتكثير.
ولما كان هذا الحكم, لا يعرف حقيقته, إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة, خصهم بالخطاب دون غيرهم.
وهذا يدل على أن الله تعالى, يحب من عباده, أن يعملوا أفكارهم وعقولهم, في تدبر ما في أحكامه, من الحكم, والمصالح الدالة على كماله, وكمال حكمته وحمده, وعدله ورحمته الواسعة وأن من كان بهذه المثابة, فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب, وناداهم رب الأرباب, وكفى بذلك فضلا, وشرفا, لقوم يعقلون.
وقوله " لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة, أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله, ويعظم معاصيه, فيتركها, فيستحق بذلك أن يكون من المتقين.
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ↓
↓
 ↓
↓أي فرض الله عليكم, يا معشر المؤمنين " إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ " أي: أسبابه, كالمرض المشرف على الهلاك, وحضور أسباب المهالك.
وكان قد " تَرَكَ خَيْرًا " وهو المال الكثير عرفا, فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف, على قدر حاله من غير سرف, ولا اقتصار على الأبعد, دون الأقرب.
بل يرتبهم على القرب والحاجة, ولهذا أتى بأفعل التفضيل.
وقوله " حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ " دل على وجوب ذلك, لأن الحق هو: الثابت وقد جعله الله من موجبات التقوى.
واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث.
وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين, مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل.
والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة, ردها الله تعالى إلى العرف الجاري.
ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث, بعد أن مجملا.
وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف, فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره.
وهذا القول تتفق عليه الأمة, ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين, لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا, واختلف المورد.
فبهذا الجمع, يحصل الاتفاق, والجمع بين الآيات, فإنه أمكن الجمع, كان أحسن من ادعاء النسخ, الذي لم يدل عليه دليل صحيح.
وكان قد " تَرَكَ خَيْرًا " وهو المال الكثير عرفا, فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف, على قدر حاله من غير سرف, ولا اقتصار على الأبعد, دون الأقرب.
بل يرتبهم على القرب والحاجة, ولهذا أتى بأفعل التفضيل.
وقوله " حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ " دل على وجوب ذلك, لأن الحق هو: الثابت وقد جعله الله من موجبات التقوى.
واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث.
وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين, مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل.
والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة, ردها الله تعالى إلى العرف الجاري.
ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث, بعد أن مجملا.
وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف, فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره.
وهذا القول تتفق عليه الأمة, ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين, لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا, واختلف المورد.
فبهذا الجمع, يحصل الاتفاق, والجمع بين الآيات, فإنه أمكن الجمع, كان أحسن من ادعاء النسخ, الذي لم يدل عليه دليل صحيح.