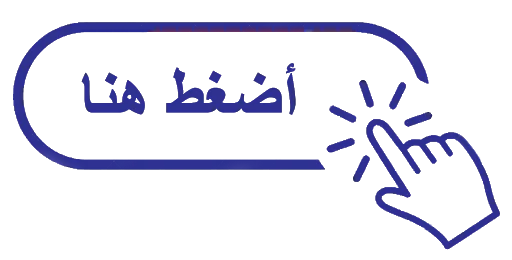" أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ " أي: من انقاد للشيطان, وأعرض عن ربه, وصار من أتباع إبليس وحزبه, مستقرهم النار.
" وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا " أي: مخلصا ولا ملجأ, بل هم خالدون فيها أبدا الآباد.
" وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا " أي: مخلصا ولا ملجأ, بل هم خالدون فيها أبدا الآباد.
وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً ↓
↓
 ↓
↓ولما بين مآل الأشقياء, أولياء الشيطان, ذكر مآل السعداء أوليائه فقال: والذين آمنوا: الآية.
أي: " آمَنُوا " بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله, واليوم الآخر, والقَدَر, خيره وشره, على الوجه الذي أمروا به, علما, وتصديقا, وإقرارا.
" وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ " الناشئة عن الإيمان.
وهذا يشمل سائر المأمورات, من واجب, ومستحب, الذي على القلب, والذي على اللسان, والذي على بقية الجوارح.
كل له, من الثواب المرتب على ذلك, بحسب حاله ومقامه, وتكميله للإيمان والعمل الصالح.
ويقويه, ما رتب على ذلك, بحسب ما أخل به من الإيمان والعمل.
وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته.
وكذلك وعده الصادق, الذي يعرف من تتبع كتاب الله وسنة رسوله.
ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: " سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ " فيها ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر, من أنواع المآكل, والمشارب اللذيذة, والمناظر العجيبة, والأزواج الحسنة, والقصور, والغرف المزخرفة والأشجار المتدلية, والفواكه المستغربة, والأصوات الشجية, والنعم السابغة وتزاور الإخوان, وتذكرهم ما كان منهم, في رياض الجنات.
وأعلى من ذلك وأجلّ, رضوان الله عليهم, وتمتع الأرواح بقربه, والعيون برؤيته, والأسماع بخطابه, الذي ينسيهم كل نعيم وسرور.
ولولا الثبات من الله لهم, لطاروا, وماتوا من الفرح والحبور.
فلله ما أحلى ذلك النعيم, وما أعلى ما أنالهم الرب الكريم, وما حصل لهم, من كل خير وبهجة, لا يصفه الواصفون.
وتمام ذلك وكماله, الخلود الدائم, في تلك المنازل العاليات, ولهذا قال: " خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا " .
فصدق الله العظيم, الذي بلغ قوله وحديثه في الصدق, أعلى ما يكون.
ولهذا لما كان كلامه صدقا, وخبره صدقا - كان ما يدل عليه, مطابقة, وتضمنا, وملازمة, كل ذلك مراد من كلامه.
وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم, لكونه لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه.
أي: " آمَنُوا " بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله, واليوم الآخر, والقَدَر, خيره وشره, على الوجه الذي أمروا به, علما, وتصديقا, وإقرارا.
" وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ " الناشئة عن الإيمان.
وهذا يشمل سائر المأمورات, من واجب, ومستحب, الذي على القلب, والذي على اللسان, والذي على بقية الجوارح.
كل له, من الثواب المرتب على ذلك, بحسب حاله ومقامه, وتكميله للإيمان والعمل الصالح.
ويقويه, ما رتب على ذلك, بحسب ما أخل به من الإيمان والعمل.
وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته.
وكذلك وعده الصادق, الذي يعرف من تتبع كتاب الله وسنة رسوله.
ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: " سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ " فيها ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر, من أنواع المآكل, والمشارب اللذيذة, والمناظر العجيبة, والأزواج الحسنة, والقصور, والغرف المزخرفة والأشجار المتدلية, والفواكه المستغربة, والأصوات الشجية, والنعم السابغة وتزاور الإخوان, وتذكرهم ما كان منهم, في رياض الجنات.
وأعلى من ذلك وأجلّ, رضوان الله عليهم, وتمتع الأرواح بقربه, والعيون برؤيته, والأسماع بخطابه, الذي ينسيهم كل نعيم وسرور.
ولولا الثبات من الله لهم, لطاروا, وماتوا من الفرح والحبور.
فلله ما أحلى ذلك النعيم, وما أعلى ما أنالهم الرب الكريم, وما حصل لهم, من كل خير وبهجة, لا يصفه الواصفون.
وتمام ذلك وكماله, الخلود الدائم, في تلك المنازل العاليات, ولهذا قال: " خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا " .
فصدق الله العظيم, الذي بلغ قوله وحديثه في الصدق, أعلى ما يكون.
ولهذا لما كان كلامه صدقا, وخبره صدقا - كان ما يدل عليه, مطابقة, وتضمنا, وملازمة, كل ذلك مراد من كلامه.
وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم, لكونه لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه.
لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا ↓
↓
 ↓
↓أي: " لَيْسَ " الأمر والنجاة والتزكية " بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ " .
والأماني: أحاديث النفس المجردة عن العمل, المقترن بها, دعوى مجردة, لو عورضت بمثلها, لكانت من جنسها.
وهذا عامّ في كل أمر.
فكيف بأمر الإيمان, والسعادة الأبدية؟!.
فإن أماني أهل الكتاب, قد أخبر الله بها, أنهم قالوا: " لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ " وغيرهم ممن ليس ينتسب لكتاب, ولا رسول, من باب أولى وأحرى.
وكذلك أدخل الله في ذلك من ينتسب إلى الإسلام, لكمال العدل والإنصاف.
فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان, لا يفيد شيئا, إن لم يأت الإنسان ببرهان, على صحة دعواه.
فالأعمال تصدق الدعوى, أو تكذبها, ولهذا قال تعالى: " مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ " وهذا شامل لجميع العاملين.
لأن السوء شامل, لأي ذنب كان, من صغائر الذنوب, وكبائرها.
وشامل أيضا, لكل جزاء, قليل, أو كثير, دنيوي, أو أخروي.
والناس في هذا المقام درجات, لا يعلمها إلا الله, فمستقل ومستكثر.
فمن كان عمله سوءا, وذلك لا يكون إلا كافرا.
فإذا مات من دون توبة, جوزي بالخلود في العذاب الأليم.
ومن كان عمله صالحا, وهو مستقيم في غالب أحواله, وإنما يصدر منه أحيانا بعض الذنوب الصغار, فما يصيبه من الهم, والغم, والأذى, وبعض الآلام, في بدنه, أو قلبه, أو حبيبه, أو ماله, ونحو ذلك - فإنها مكفرات للذنوب, لطفا من الله بعباده.
وبين هذين الحالين مراتب كثيرة.
وهذا الجزاء, على عمل السوء العام, مخصوص في غير التائبين.
فإن التائب من الذنب, كمن لا ذنب له, كما دلت على ذلك النصوص.
وقوله " وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا " لإزالة بعض ما لعله يتوهم, أن من استحق المجازاة على عمله, قد يكون له ولي, أو ناصر, أو شافع, يدفع عنه ما استحقه.
فأخبر تعالى, بانتفاء ذلك, فليس له ولي, يحصل له المطلوب, ولا نصير يدفع عنه المرهوب, إلا ربه ومليكه.
والأماني: أحاديث النفس المجردة عن العمل, المقترن بها, دعوى مجردة, لو عورضت بمثلها, لكانت من جنسها.
وهذا عامّ في كل أمر.
فكيف بأمر الإيمان, والسعادة الأبدية؟!.
فإن أماني أهل الكتاب, قد أخبر الله بها, أنهم قالوا: " لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ " وغيرهم ممن ليس ينتسب لكتاب, ولا رسول, من باب أولى وأحرى.
وكذلك أدخل الله في ذلك من ينتسب إلى الإسلام, لكمال العدل والإنصاف.
فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان, لا يفيد شيئا, إن لم يأت الإنسان ببرهان, على صحة دعواه.
فالأعمال تصدق الدعوى, أو تكذبها, ولهذا قال تعالى: " مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ " وهذا شامل لجميع العاملين.
لأن السوء شامل, لأي ذنب كان, من صغائر الذنوب, وكبائرها.
وشامل أيضا, لكل جزاء, قليل, أو كثير, دنيوي, أو أخروي.
والناس في هذا المقام درجات, لا يعلمها إلا الله, فمستقل ومستكثر.
فمن كان عمله سوءا, وذلك لا يكون إلا كافرا.
فإذا مات من دون توبة, جوزي بالخلود في العذاب الأليم.
ومن كان عمله صالحا, وهو مستقيم في غالب أحواله, وإنما يصدر منه أحيانا بعض الذنوب الصغار, فما يصيبه من الهم, والغم, والأذى, وبعض الآلام, في بدنه, أو قلبه, أو حبيبه, أو ماله, ونحو ذلك - فإنها مكفرات للذنوب, لطفا من الله بعباده.
وبين هذين الحالين مراتب كثيرة.
وهذا الجزاء, على عمل السوء العام, مخصوص في غير التائبين.
فإن التائب من الذنب, كمن لا ذنب له, كما دلت على ذلك النصوص.
وقوله " وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا " لإزالة بعض ما لعله يتوهم, أن من استحق المجازاة على عمله, قد يكون له ولي, أو ناصر, أو شافع, يدفع عنه ما استحقه.
فأخبر تعالى, بانتفاء ذلك, فليس له ولي, يحصل له المطلوب, ولا نصير يدفع عنه المرهوب, إلا ربه ومليكه.
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ↓
↓
 ↓
↓" وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ " دخل في ذلك, سائر الأعمال القلبية والبدنية.
ودخل أيضا, كل عامل, من إنس, أو جن, صغير, أو كبير, ذكر, أو أنثى.
ولهذا قال " مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ " وهذا شرط لجميع الأعمال لا تكون صالحة, ولا تقبل, ولا يترتب عليها الثواب, ولا يندفع بها العقاب, إلا بالإيمان.
فالأعمال بدون الإيمان, كأغصان شجرة, قطع أصلها, وكبناء, بني على موج الماء.
فالإيمان, هو الأصل والأساس, والقاعدة, التي يبنى عليها كل شيء.
وهذا القيد, ينبغي التفطن له, في كل عمل مطلق, فإنه مقيد به.
" فَأُولَئِكَ " أي: الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح.
" يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ " المشتملة على ما تشتهي الأنفس, وتلذ الأعين.
" وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا " أي: لا قليلا ولا كثيرا, مما عملوه من الخير.
بل يجدونه كاملا موفرا, مضاعفا أضعافا كثيرة.
ودخل أيضا, كل عامل, من إنس, أو جن, صغير, أو كبير, ذكر, أو أنثى.
ولهذا قال " مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ " وهذا شرط لجميع الأعمال لا تكون صالحة, ولا تقبل, ولا يترتب عليها الثواب, ولا يندفع بها العقاب, إلا بالإيمان.
فالأعمال بدون الإيمان, كأغصان شجرة, قطع أصلها, وكبناء, بني على موج الماء.
فالإيمان, هو الأصل والأساس, والقاعدة, التي يبنى عليها كل شيء.
وهذا القيد, ينبغي التفطن له, في كل عمل مطلق, فإنه مقيد به.
" فَأُولَئِكَ " أي: الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح.
" يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ " المشتملة على ما تشتهي الأنفس, وتلذ الأعين.
" وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا " أي: لا قليلا ولا كثيرا, مما عملوه من الخير.
بل يجدونه كاملا موفرا, مضاعفا أضعافا كثيرة.
وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّه وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ↓
↓
 ↓
↓أي: لا أحد أحسن من دين, من جمع بين الإخلاص للمعبود, وهو: إسلام الوجه لله, الدال على استسلام القلب وتوجهه, وإنابته, وإخلاصه وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله.
[وهو] مع هذا الإخلاص والاستسلام [محسن] أي: متبع لشريعة الله, التي أرسل الله بها رسله, وأنزل كتبه, وجعلها طريقا لخواص خلقه وأتباعهم.
" وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ " أي: دينه وشرعه " حَنِيفًا " أي: مائلا عن الشرك إلى التوحيد, وعن التوجه للخلق, إلى الإقبال على الخالق.
" وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا " والخلة أعلى أنواع المحبة.
وهذه المرتبة, حصلت للخليلين, محمد, وإبراهيم, عليهما الصلاة والسلام.
وأما المحبة من الله, فهي لعموم المؤمنين.
وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلا, لأنه وفَّى بما أُمر به, وقام بما ابْتُلي به.
فجعله الله إماما للناس, واتخذه خليلا, ونوه بذكره في العالمين.
[وهو] مع هذا الإخلاص والاستسلام [محسن] أي: متبع لشريعة الله, التي أرسل الله بها رسله, وأنزل كتبه, وجعلها طريقا لخواص خلقه وأتباعهم.
" وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ " أي: دينه وشرعه " حَنِيفًا " أي: مائلا عن الشرك إلى التوحيد, وعن التوجه للخلق, إلى الإقبال على الخالق.
" وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا " والخلة أعلى أنواع المحبة.
وهذه المرتبة, حصلت للخليلين, محمد, وإبراهيم, عليهما الصلاة والسلام.
وأما المحبة من الله, فهي لعموم المؤمنين.
وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلا, لأنه وفَّى بما أُمر به, وقام بما ابْتُلي به.
فجعله الله إماما للناس, واتخذه خليلا, ونوه بذكره في العالمين.
وهذه الآية الكريمة, فيها بيان إحاطة الله تعالى بجميع الأشياء.
فأخبر أنه له " مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ " أي: الجميع ملكه وعبيده.
فهم المملوكون, وهو المالك المتفرد بتدبيرهم.
وقد أحاط علمه بجميع المعلومات, وبصره بجميع المبصرات, وسمعه بجميع المسموعات, ونفذت مشيئته وقدرته, بجميع الموجودات, ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات, وقهر بعزه وقهره, كل مخلوق, ودانت له جميع الأشياء.
فأخبر أنه له " مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ " أي: الجميع ملكه وعبيده.
فهم المملوكون, وهو المالك المتفرد بتدبيرهم.
وقد أحاط علمه بجميع المعلومات, وبصره بجميع المبصرات, وسمعه بجميع المسموعات, ونفذت مشيئته وقدرته, بجميع الموجودات, ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات, وقهر بعزه وقهره, كل مخلوق, ودانت له جميع الأشياء.
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ↓
↓
 ↓
↓الاستفتاء: طلب السائل من المسئول, بيان الحكم الشرعي في ذلك المسئول عنه.
فأخبر عن المؤمنين, أنهم يستفتون الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلق بهم فتولى الله هذه الفتوى بنفسه فقال: " قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " فاعملوا على ما أفتاكم به, في جميع شئون النساء, من القيام بحقوقهن, وترك ظلمهن, عموما وخصوصا.
وهذا أمر عام, يشمل جميع ما شرع الله, أمرا, ونهيا, في حق النساء, الزوجات وغيرهن, الصغار والكبار.
ثم خص - بعد التعميم - الوصية بالضعاف, من اليتامى, والولدان, اهتماما بهم, وزجرا عن التفريط في حقوقهم فقال: " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ " أي: ويفتيكم أيضا, بما يتلى عليكم في الكتاب, في شأن اليتامى من النساء.
" اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ " .
وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت.
فإن اليتيمة, إذا كانت تحت ولاية الرجل, بخسها حقها, وظلمها, إما بأكل مالها الذي لها, أو بعضه, أو منعها من التزوج, لينتفع بمالها, خوفا من استخراجه من يده, إنْ زوَّجها, أو يأخذ من صهرها, الذي تتزوج به, بشرط أو غيره, هذا إذا كان راغبا عنها.
أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال, ولا يقسط في مهرها, بل يعطيها دون ما تستحق.
فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص, ولهذا قال: " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " أي: ترغبون عن نكاحهن, أو في نكاحهن كما ذكرنا تمثيله.
" وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ " أي: ويفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار, أن تعطوهم حقهم, من الميراث, وغيره, وأن لا تستولوا على أموالهم, على وجه الظلم والاستبداد.
" وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ " أي: بالعدل التام.
وهذا يشمل القيام عليهم, بإلزامهم أمر الله, وما أوجبه على عباده, فيكون الأولياء, مكلفين بذلك, يلزمونهم بما أوجبه الله.
ويشمل القيام عليهم, في مصالحهم الدنيوية, بتنمية أموالهم, وطلب الأحظ لهم فيها, وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن.
وكذلك لا يحابون فيهم, صديقا ولا غيره, في تزوج وغيره, على وجه الهضم لحقوقهم وهذا من رحمته تعالى بعباده, حيث حثّ غاية الحث, على القيام بمصالح من لا يقوم بمصلحة نفسه, لضعفه, وفقد أبيه.
ثم حثّ على الإحسان عموما, فقال: " وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ " لليتامى ولغيرهم, سواء كان الخير متعديا, أو لازما.
" فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا " أي: قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير, قلة وكثرة, حسنا وضده, فيجازي كُلًّا بحسب عمله.
فأخبر عن المؤمنين, أنهم يستفتون الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلق بهم فتولى الله هذه الفتوى بنفسه فقال: " قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " فاعملوا على ما أفتاكم به, في جميع شئون النساء, من القيام بحقوقهن, وترك ظلمهن, عموما وخصوصا.
وهذا أمر عام, يشمل جميع ما شرع الله, أمرا, ونهيا, في حق النساء, الزوجات وغيرهن, الصغار والكبار.
ثم خص - بعد التعميم - الوصية بالضعاف, من اليتامى, والولدان, اهتماما بهم, وزجرا عن التفريط في حقوقهم فقال: " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ " أي: ويفتيكم أيضا, بما يتلى عليكم في الكتاب, في شأن اليتامى من النساء.
" اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ " .
وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت.
فإن اليتيمة, إذا كانت تحت ولاية الرجل, بخسها حقها, وظلمها, إما بأكل مالها الذي لها, أو بعضه, أو منعها من التزوج, لينتفع بمالها, خوفا من استخراجه من يده, إنْ زوَّجها, أو يأخذ من صهرها, الذي تتزوج به, بشرط أو غيره, هذا إذا كان راغبا عنها.
أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال, ولا يقسط في مهرها, بل يعطيها دون ما تستحق.
فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص, ولهذا قال: " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " أي: ترغبون عن نكاحهن, أو في نكاحهن كما ذكرنا تمثيله.
" وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ " أي: ويفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار, أن تعطوهم حقهم, من الميراث, وغيره, وأن لا تستولوا على أموالهم, على وجه الظلم والاستبداد.
" وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ " أي: بالعدل التام.
وهذا يشمل القيام عليهم, بإلزامهم أمر الله, وما أوجبه على عباده, فيكون الأولياء, مكلفين بذلك, يلزمونهم بما أوجبه الله.
ويشمل القيام عليهم, في مصالحهم الدنيوية, بتنمية أموالهم, وطلب الأحظ لهم فيها, وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن.
وكذلك لا يحابون فيهم, صديقا ولا غيره, في تزوج وغيره, على وجه الهضم لحقوقهم وهذا من رحمته تعالى بعباده, حيث حثّ غاية الحث, على القيام بمصالح من لا يقوم بمصلحة نفسه, لضعفه, وفقد أبيه.
ثم حثّ على الإحسان عموما, فقال: " وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ " لليتامى ولغيرهم, سواء كان الخير متعديا, أو لازما.
" فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا " أي: قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير, قلة وكثرة, حسنا وضده, فيجازي كُلًّا بحسب عمله.
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ↓
↓
 ↓
↓أي: إذا خافت المرأة نشوز زوجها, أي ترفعه عنها, وعدم رغبته فيها, وإعراضه عنها, فالأحسن في هذه الحالة, أن يصلحا بينهما صلحا, بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها, على وجه تبقى مع زوجها.
إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة, أو الكسوة, أو المسكن, أو القسم, بأن تسقط حقها منه.
أو تهب يومها وليلتها, لزوجها, أو لضرتها.
فإذا اتفقا على هذه الحالة, فلا جناح ولا بأس عليهما فيها, لا عليها, ولا على الزوج.
فيجوز حينئذ لزوجها, البقاء معها على هذه الحال, وهي خير من الفرقة.
ولهذا قال: " وَالصُّلْحُ خَيْرٌ " .
ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى, أن الصلح بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء, أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه, لما فيه من الإصلاح, وبقاء الألفة, والاتصاف بصفة السماح.
وهو جائز في جميع الأشياء, إلا إذا أحلّ حراما, أو حرّم حلالا, فإنه لا يكون صلحا, وإنما يكون جورا.
واعلم أن كل حكم من الأحكام, لا يتم, ولا يكمل, إلا بوجود مقتضيه, وانتفاء موانعه.
فمن ذلك, هذا الحكم الكبير, الذي هو الصلح.
فذكر تعالى المقتضي لذلك, ونبه على أنه خير, والخير كل عامل يطلبه, ويرغب فيه.
فإن كان - مع ذلك - قد أمر الله به, وحثّ عليه ازداد المؤمن طلبا له, ورغبة فيه.
وذكر المانع بقوله " وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ " أي: جبلت النفوس على الشح, وهو: عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان, والحرص على الحق الذي له.
فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا.
أي ينبغي لكم, أن تحرصوا على قلع هذا الخُلُق الدنيء, من نفوسكم, وتستبدلوا به, ضده وهو: السماحة, وهو بذل الحق الذي عليك, والاقتناع ببعض الحق الذي لك.
فمتى وفق الإنسان لهذا الخُلُق الحسن, سهل - حينئذ - عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله, وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب.
بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه, فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة, لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله, ولا يرضى أن يؤدي ما عليه.
فإن كان خصمه مثله, اشتد الأمر.
ثم قال: " وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا " أي: تحسنوا في عبادة الخالق, بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه, فإن لم يكن يراه, فإنه يراه.
وتحسنوا إلى المخلوقين, بجميع طرق الإحسان, من نفع بمال, أو علم, أو جاه, أو غير ذلك.
" وَتَتَّقُوا " الله, بفعل جميع المأمورات, وترك جميع المحظورات.
أو تحسنوا بفعل المأمور, وتتقوا بترك المحظور.
" فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا " قد أحاط به, علما وخبرا, بظاهره وباطنه, فيحفظه لكم, ويجازيكم عليه, أتم الجزاء.
إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة, أو الكسوة, أو المسكن, أو القسم, بأن تسقط حقها منه.
أو تهب يومها وليلتها, لزوجها, أو لضرتها.
فإذا اتفقا على هذه الحالة, فلا جناح ولا بأس عليهما فيها, لا عليها, ولا على الزوج.
فيجوز حينئذ لزوجها, البقاء معها على هذه الحال, وهي خير من الفرقة.
ولهذا قال: " وَالصُّلْحُ خَيْرٌ " .
ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى, أن الصلح بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء, أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه, لما فيه من الإصلاح, وبقاء الألفة, والاتصاف بصفة السماح.
وهو جائز في جميع الأشياء, إلا إذا أحلّ حراما, أو حرّم حلالا, فإنه لا يكون صلحا, وإنما يكون جورا.
واعلم أن كل حكم من الأحكام, لا يتم, ولا يكمل, إلا بوجود مقتضيه, وانتفاء موانعه.
فمن ذلك, هذا الحكم الكبير, الذي هو الصلح.
فذكر تعالى المقتضي لذلك, ونبه على أنه خير, والخير كل عامل يطلبه, ويرغب فيه.
فإن كان - مع ذلك - قد أمر الله به, وحثّ عليه ازداد المؤمن طلبا له, ورغبة فيه.
وذكر المانع بقوله " وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ " أي: جبلت النفوس على الشح, وهو: عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان, والحرص على الحق الذي له.
فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا.
أي ينبغي لكم, أن تحرصوا على قلع هذا الخُلُق الدنيء, من نفوسكم, وتستبدلوا به, ضده وهو: السماحة, وهو بذل الحق الذي عليك, والاقتناع ببعض الحق الذي لك.
فمتى وفق الإنسان لهذا الخُلُق الحسن, سهل - حينئذ - عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله, وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب.
بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه, فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة, لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله, ولا يرضى أن يؤدي ما عليه.
فإن كان خصمه مثله, اشتد الأمر.
ثم قال: " وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا " أي: تحسنوا في عبادة الخالق, بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه, فإن لم يكن يراه, فإنه يراه.
وتحسنوا إلى المخلوقين, بجميع طرق الإحسان, من نفع بمال, أو علم, أو جاه, أو غير ذلك.
" وَتَتَّقُوا " الله, بفعل جميع المأمورات, وترك جميع المحظورات.
أو تحسنوا بفعل المأمور, وتتقوا بترك المحظور.
" فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا " قد أحاط به, علما وخبرا, بظاهره وباطنه, فيحفظه لكم, ويجازيكم عليه, أتم الجزاء.
وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ↓
↓
 ↓
↓يخبر تعالى: أن الأزواج لا يستطيعون, وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء.
وذلك, لأن العدل: يستلزم وجود المحبة على السواء, والداعي على السواء, والميل في القلب إليهن على السواء, ثم العمل بمقتضى ذلك.
وهذا متعذر غير ممكن, فلذلك عفا الله, عما لا يستطاع ونهى عما هو ممكن بقوله: " فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ " أي: لا تميلوا ميلا كثيرا, بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة.
بل افعلوا ما هو باستطاعتكم في العدل.
فالنفقة والكسوة, والقسم ونحوها, عليكم أن تعدلوا بينهن فيها.
بخلاف الحب, والوطء ونحو ذلك, فإن الزوجة, إذا ترك زوجها, ما يجب لها, صارت كالمعلقة, التي لا زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج, ولا ذات زوج, يقوم بحقوقها.
" وَإِنْ تُصْلِحُوا " ما بينكم وبين زوجاتكم.
وبإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس, احتسابا وقياما بحق الزوجة.
وتصلحوا أيضا, فيما بينكم وبين الناس.
وتصلحوا أيضا بين الناس, فيما تنازعوا فيه.
وهذا يستلزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم.
" وَتَتَّقُوا " الله بفعل المأمور وترك المحظور, والصبر على المقدور.
" فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا " يغفر ما صدر منكم, من الذنوب, والتقصير في الحق الواجب, ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن.
وذلك, لأن العدل: يستلزم وجود المحبة على السواء, والداعي على السواء, والميل في القلب إليهن على السواء, ثم العمل بمقتضى ذلك.
وهذا متعذر غير ممكن, فلذلك عفا الله, عما لا يستطاع ونهى عما هو ممكن بقوله: " فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ " أي: لا تميلوا ميلا كثيرا, بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة.
بل افعلوا ما هو باستطاعتكم في العدل.
فالنفقة والكسوة, والقسم ونحوها, عليكم أن تعدلوا بينهن فيها.
بخلاف الحب, والوطء ونحو ذلك, فإن الزوجة, إذا ترك زوجها, ما يجب لها, صارت كالمعلقة, التي لا زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج, ولا ذات زوج, يقوم بحقوقها.
" وَإِنْ تُصْلِحُوا " ما بينكم وبين زوجاتكم.
وبإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس, احتسابا وقياما بحق الزوجة.
وتصلحوا أيضا, فيما بينكم وبين الناس.
وتصلحوا أيضا بين الناس, فيما تنازعوا فيه.
وهذا يستلزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم.
" وَتَتَّقُوا " الله بفعل المأمور وترك المحظور, والصبر على المقدور.
" فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا " يغفر ما صدر منكم, من الذنوب, والتقصير في الحق الواجب, ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن.
هذه الحالة الثالثة بين الزوجين, إذا تعذر الاتفاق, فإنه لا بأس بالفراق.
فقال " وَإِنْ يَتَفَرَّقَا " أي: بطلاق, أو فسخ, أو خلع, أو غير ذلك.
" يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا " من الزوجين " مِنْ سَعَتِهِ " أي: من فضله, وإحسانه الواسع الشامل.
فيغني الزوج بزوجة, خير له منها, ويغنيها من فضله.
وإن انقطع نصيبها من زوجها, فإن رزقها على المتكفل بأرزاق جميع الخلق, القائم بمصالحهم, ولعل الله يرزقها, زوجا خيرا منه.
" وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا " أي: كثير الفضل, واسع الرحمة.
وصلت رحمته وإحسانه, إلى حيث وصل إليه علمه.
وكان - مع ذلك - " حَكِيمًا " أي: يعطي بحكمته, ويمنع لحكمته.
فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده, من إحسانه, بسبب في العبد, لا يستحق معه الإحسان - حرمه, عدلا وحكمة.
فقال " وَإِنْ يَتَفَرَّقَا " أي: بطلاق, أو فسخ, أو خلع, أو غير ذلك.
" يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا " من الزوجين " مِنْ سَعَتِهِ " أي: من فضله, وإحسانه الواسع الشامل.
فيغني الزوج بزوجة, خير له منها, ويغنيها من فضله.
وإن انقطع نصيبها من زوجها, فإن رزقها على المتكفل بأرزاق جميع الخلق, القائم بمصالحهم, ولعل الله يرزقها, زوجا خيرا منه.
" وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا " أي: كثير الفضل, واسع الرحمة.
وصلت رحمته وإحسانه, إلى حيث وصل إليه علمه.
وكان - مع ذلك - " حَكِيمًا " أي: يعطي بحكمته, ويمنع لحكمته.
فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده, من إحسانه, بسبب في العبد, لا يستحق معه الإحسان - حرمه, عدلا وحكمة.
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ↓
↓
 ↓
↓يخبر تعالى, عن عموم ملكه العظيم الواسع, المستلزم تدبيره, بجميع أنواع التدبير, وتصرفه بأنواع التصريف, قدرا, وشرعا.
فتصرفه الشرعي, أن وصى الأولين والآخرين, أهل الكتب السابقة واللاحقة - بالتقوى المتضمنة للأمر والنهي, وتشريع الأحكام, والمجازاة لمن قام بهذه الوصية, بالثواب, والمعاقبة لمن أهملها وضيعها, بأليم العذاب.
ولهذا قال " وَإِنْ تَكْفُرُوا " بأن تتركوا تقوى الله, وتشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا, فإنكم لا تضرون بذلك, إلا أنفسكم, ولا تضرون الله شيئا, ولا تنقصون ملكه.
وله عبيد خير منكم, وأعظم, وأكثر, مطيعون له, خاضعون لأمره.
ولهذا رتب على ذلك قوله " وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا " له الجود الكامل والإحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته, التي لا ينقصها الإنفاق, ولا يغيضها نفقة, سحاء الليل والنهار.
لو اجتمع أهل السماوات, وأهل الأرض, أولهم وآخرهم, فسأل كل واحد منهم, ما بلغت أمانيه, ما نقص من ملكه شيئا.
ذلك بأنه جواد واجد ماجد, عطاؤه كلام, وعذابه كلام.
إنما أمره لشيء إذا أراد شيئا, أن يقول له كن فيكون.
ومن تمام غناه, أنه كامل الأوصاف.
إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه, لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال.
بل, له كل صفة كمال, ومن تلك الصفة كمالها.
ومن تمام غناه, أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا, ولا شريكا في ملكه, ولا ظهيرا, ولا معاونا له على شيء, من تدابير ملكه.
ومن كمال غناه, افتقار العالم العلوي والسفلي, في جميع أحوالهم وشئونهم إليه, وسؤالهم إياه, جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة.
فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة, وأغناهم وأقناهم, ومَنَّ عليهم بلطفه, وهداهم.
وأما الحميد, فهو من أسماء الله تعالى الجليلة, الدال على أنه هو المستحق لكل حمد, ومحبة, وثناء وإكرام.
وذلك لما اتصف به من صفات الحمد, التي هي صفة الجمال والجلال, ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال, فهو المحمود على كل حال.
وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين " الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ " !! فإنه غني محمود, فله كمال من غناه, وكمال من حمده, وكمال من اقتران أحدهما بالآخر.
فتصرفه الشرعي, أن وصى الأولين والآخرين, أهل الكتب السابقة واللاحقة - بالتقوى المتضمنة للأمر والنهي, وتشريع الأحكام, والمجازاة لمن قام بهذه الوصية, بالثواب, والمعاقبة لمن أهملها وضيعها, بأليم العذاب.
ولهذا قال " وَإِنْ تَكْفُرُوا " بأن تتركوا تقوى الله, وتشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا, فإنكم لا تضرون بذلك, إلا أنفسكم, ولا تضرون الله شيئا, ولا تنقصون ملكه.
وله عبيد خير منكم, وأعظم, وأكثر, مطيعون له, خاضعون لأمره.
ولهذا رتب على ذلك قوله " وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا " له الجود الكامل والإحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته, التي لا ينقصها الإنفاق, ولا يغيضها نفقة, سحاء الليل والنهار.
لو اجتمع أهل السماوات, وأهل الأرض, أولهم وآخرهم, فسأل كل واحد منهم, ما بلغت أمانيه, ما نقص من ملكه شيئا.
ذلك بأنه جواد واجد ماجد, عطاؤه كلام, وعذابه كلام.
إنما أمره لشيء إذا أراد شيئا, أن يقول له كن فيكون.
ومن تمام غناه, أنه كامل الأوصاف.
إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه, لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال.
بل, له كل صفة كمال, ومن تلك الصفة كمالها.
ومن تمام غناه, أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا, ولا شريكا في ملكه, ولا ظهيرا, ولا معاونا له على شيء, من تدابير ملكه.
ومن كمال غناه, افتقار العالم العلوي والسفلي, في جميع أحوالهم وشئونهم إليه, وسؤالهم إياه, جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة.
فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة, وأغناهم وأقناهم, ومَنَّ عليهم بلطفه, وهداهم.
وأما الحميد, فهو من أسماء الله تعالى الجليلة, الدال على أنه هو المستحق لكل حمد, ومحبة, وثناء وإكرام.
وذلك لما اتصف به من صفات الحمد, التي هي صفة الجمال والجلال, ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال, فهو المحمود على كل حال.
وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين " الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ " !! فإنه غني محمود, فله كمال من غناه, وكمال من حمده, وكمال من اقتران أحدهما بالآخر.
ثم كرر إحاطة ملكه, لما في السماوات والأرض, وأنه على كل شيء وكيل.
أي: عالم قائم بتدبير الأشياء, على وجه الحكمة, فإن ذلك, من تمام الوكالة.
فإن الوكالة تستلزم العلم بما هو وكيل عليه, والقوة, والقدرة على تنفيذه وتدبيره وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة والمصلحة.
فما نقص من ذلك, فهو لنقص بالوكيل.
والله تعالى منزه عن كل نقص.
أي: هو الغني الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم.
أي: عالم قائم بتدبير الأشياء, على وجه الحكمة, فإن ذلك, من تمام الوكالة.
فإن الوكالة تستلزم العلم بما هو وكيل عليه, والقوة, والقدرة على تنفيذه وتدبيره وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة والمصلحة.
فما نقص من ذلك, فهو لنقص بالوكيل.
والله تعالى منزه عن كل نقص.
أي: هو الغني الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم.
إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ↓
↓
 ↓
↓" إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ " غيركم, هم أطوع لله منكم وخير منكم.
وفي هذا تهديد للناس على إقامتهم على كفرهم, وإعراضهم عن ربهم, فإن الله لا يعبأ بهم شيئا, إن لم يطيعوه, ولكنه يمهل, ويملي, ولا يهمل.
وفي هذا تهديد للناس على إقامتهم على كفرهم, وإعراضهم عن ربهم, فإن الله لا يعبأ بهم شيئا, إن لم يطيعوه, ولكنه يمهل, ويملي, ولا يهمل.
مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ↓
↓
 ↓
↓ثم أخبر أن من كانت همته وإرادته دنية, غير متجاوزة ثواب الدنيا, وليس له إرادة في الآخرة, فإنه قد قصر سعيه ونظره, ومع ذلك فلا يحصل له من ثواب الدنيا, سوى ما كتب الله له منها.
فإنه تعالى, هو المالك لكل شيء, الذي عنده ثواب الدنيا والآخرة, فليطلبا منه, وليستعن به عليهما.
قإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته, ولا تدرك الأمور الدينية والدنيوية إلا بالاستعانة به, والافتقار إليه على الدوام.
وله الحكمة تعالى, في توفيق من يوفقه, وخذلان من يخذله, وفي إعطائه ومنعه.
ولهذا قال " وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا " .
ثم قال تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ " الآيتين.
فإنه تعالى, هو المالك لكل شيء, الذي عنده ثواب الدنيا والآخرة, فليطلبا منه, وليستعن به عليهما.
قإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته, ولا تدرك الأمور الدينية والدنيوية إلا بالاستعانة به, والافتقار إليه على الدوام.
وله الحكمة تعالى, في توفيق من يوفقه, وخذلان من يخذله, وفي إعطائه ومنعه.
ولهذا قال " وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا " .
ثم قال تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ " الآيتين.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ↓
↓
 ↓
↓يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا " قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ " .
والقوام, صيغة مبالغة, أي: كونوا في كل أحوالكم, قائمين بالقسط, الذي هو العدل في حقوق الله, وحقوق عباده.
فالقسط في حقوق الله, أن لا يستعان بنعمه على معصيته, بل تصرف في طاعته.
والقسط في حقوق الآدميين, أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك, كما تطلب حقوقك.
فتؤدي النفقات الواجبة, والديون, وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به, من الأخلاق والمكافأة, وغير ذلك.
ومن أعظم أنواع القسط, القسط في المقالات والقائلين.
فلا يحكم لأحد القولين, أو أحد المتنازعين, لانتسابه أو ميله لأحدهما.
بل يجعل وجهته, العدل بينهما.
ومن القسط أداء الشهادة, التي عندك على أي وجه كان, حتى على الأحباب, بل على النفس, ولهذا قال: " شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا " .
أي: فلا تراعوا الغني لغناه, ولا الفقير - بزعمكم - رحمة له.
بل اشهدوا بالحق, على من كان.
والقيام بالقسط, من أعظم الأمور, وأدلها على دين القائم به, وورعه ومقامه في الإسلام.
فيتعين على من نصح نفسه, وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام, وأن يجعله نُصْب عينيه, ومحل إرادته, وأن يزيل عن نفسه, كل مانع وعائق يعوقه, عن إرادة القسط, أو العمل به.
وأعظم عائق لذلك, اتباع الهوى, ولهذا, نبه تعالى, على إزالة هذا المانع بقوله: " فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا " أي: فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق.
فإنكم - إن اتبعتموها, عدلتم عن الصواب, ولم توفقوا للعدل.
فإن الهوى, إما أن يعمي بصيرة صاحبه, حتى يرى الحق باطلا, والباطل حقا.
وإما أن يعرف الحق ويتركه, لأجل هواه.
فمن سلم من هوى نفسه, وفق للحق, وهدي إلى الصراط المستقيم.
ولما بين أن الواجب, القيام بالقسط, نهى عن ما يضاد ذلك, وهو لي اللسان عن الحق, في الشهادات وغيرها, وتحريف النطق, عن الصواب المقصود من كل وجه, أو من بعض الوجوه.
ويدخل في ذلك, تحريف الشهادة, وعدم تكميلها, أو تأويل الشاهد على أمر آحر.
فإن هذا, من اللي, لأنه الانحراف عن الحق.
" أَوْ تُعْرِضُوا " أي: تتركوا القسط المنوط بكم, كترك الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه, الذي يجب عليه القيام به.
" فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا " أي: محيطا بما فعلتم, يعلم أعمالكم, خفيها وجليها.
وفي هذا تهديد شديد, للذي يلوي أو يعرض.
ومن باب أولى, الذي يحكم بالباطل, أو يشهد بالزور, لأنه أعظم جرما.
لأن الأولين, تركا الحق, وقام هو بالباطل.
والقوام, صيغة مبالغة, أي: كونوا في كل أحوالكم, قائمين بالقسط, الذي هو العدل في حقوق الله, وحقوق عباده.
فالقسط في حقوق الله, أن لا يستعان بنعمه على معصيته, بل تصرف في طاعته.
والقسط في حقوق الآدميين, أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك, كما تطلب حقوقك.
فتؤدي النفقات الواجبة, والديون, وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به, من الأخلاق والمكافأة, وغير ذلك.
ومن أعظم أنواع القسط, القسط في المقالات والقائلين.
فلا يحكم لأحد القولين, أو أحد المتنازعين, لانتسابه أو ميله لأحدهما.
بل يجعل وجهته, العدل بينهما.
ومن القسط أداء الشهادة, التي عندك على أي وجه كان, حتى على الأحباب, بل على النفس, ولهذا قال: " شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا " .
أي: فلا تراعوا الغني لغناه, ولا الفقير - بزعمكم - رحمة له.
بل اشهدوا بالحق, على من كان.
والقيام بالقسط, من أعظم الأمور, وأدلها على دين القائم به, وورعه ومقامه في الإسلام.
فيتعين على من نصح نفسه, وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام, وأن يجعله نُصْب عينيه, ومحل إرادته, وأن يزيل عن نفسه, كل مانع وعائق يعوقه, عن إرادة القسط, أو العمل به.
وأعظم عائق لذلك, اتباع الهوى, ولهذا, نبه تعالى, على إزالة هذا المانع بقوله: " فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا " أي: فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق.
فإنكم - إن اتبعتموها, عدلتم عن الصواب, ولم توفقوا للعدل.
فإن الهوى, إما أن يعمي بصيرة صاحبه, حتى يرى الحق باطلا, والباطل حقا.
وإما أن يعرف الحق ويتركه, لأجل هواه.
فمن سلم من هوى نفسه, وفق للحق, وهدي إلى الصراط المستقيم.
ولما بين أن الواجب, القيام بالقسط, نهى عن ما يضاد ذلك, وهو لي اللسان عن الحق, في الشهادات وغيرها, وتحريف النطق, عن الصواب المقصود من كل وجه, أو من بعض الوجوه.
ويدخل في ذلك, تحريف الشهادة, وعدم تكميلها, أو تأويل الشاهد على أمر آحر.
فإن هذا, من اللي, لأنه الانحراف عن الحق.
" أَوْ تُعْرِضُوا " أي: تتركوا القسط المنوط بكم, كترك الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه, الذي يجب عليه القيام به.
" فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا " أي: محيطا بما فعلتم, يعلم أعمالكم, خفيها وجليها.
وفي هذا تهديد شديد, للذي يلوي أو يعرض.
ومن باب أولى, الذي يحكم بالباطل, أو يشهد بالزور, لأنه أعظم جرما.
لأن الأولين, تركا الحق, وقام هو بالباطل.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيدًا ↓
↓
 ↓
↓اعلم أن الأمر, إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه.
فهذا يكون أمرا له في الدخول فيه.
وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان كقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ " الآية وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء, فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد.
ومنه ما ذكره الله في هذه الآية, من أمر المؤمنين بالإيمان.
فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم, من الإخلاص والصدق, وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات.
ويقتضي أيضا, الأمر بما لم يوجد من المؤمن, من علوم الإيمان وأعماله.
فإنه كلما وصل إليه نص, وفهم معناه, واعتقده, فإن ذلك من المأمور به.
وكذلك سائر الأعمال الظاهرة, والباطنة, كلها من الإيمان, كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة, وأجمع عليه سلف الأمة.
ثم الاستمرار على ذلك, والثبات عليه إلى الممات كما قال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ " .
وأمر هنا بالإيمان به, وبرسله, وبالقرآن, وبالكتب المتقدمة.
فهذا كله من الإيمان الواجب, الذي لا يكون العبد مؤمنا إلا به.
إجمالا فيما لم يصل إليه تفصيله, وتفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل.
فمن آمن هذا الإيمان المأمور به, فقد اهتدى وأنجح.
" وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا " .
وأي ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيم, وسلك الطريق الموصلة له إلى العذاب الأليم؟!! واعلم أن الكفر بشيء من هذه الأمور المذكورة, كالكفر بجميعها, لتلازمها, وامتناع وجود الإيمان ببعضها, دون بعض.
فهذا يكون أمرا له في الدخول فيه.
وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان كقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ " الآية وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء, فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد.
ومنه ما ذكره الله في هذه الآية, من أمر المؤمنين بالإيمان.
فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم, من الإخلاص والصدق, وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات.
ويقتضي أيضا, الأمر بما لم يوجد من المؤمن, من علوم الإيمان وأعماله.
فإنه كلما وصل إليه نص, وفهم معناه, واعتقده, فإن ذلك من المأمور به.
وكذلك سائر الأعمال الظاهرة, والباطنة, كلها من الإيمان, كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة, وأجمع عليه سلف الأمة.
ثم الاستمرار على ذلك, والثبات عليه إلى الممات كما قال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ " .
وأمر هنا بالإيمان به, وبرسله, وبالقرآن, وبالكتب المتقدمة.
فهذا كله من الإيمان الواجب, الذي لا يكون العبد مؤمنا إلا به.
إجمالا فيما لم يصل إليه تفصيله, وتفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل.
فمن آمن هذا الإيمان المأمور به, فقد اهتدى وأنجح.
" وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا " .
وأي ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيم, وسلك الطريق الموصلة له إلى العذاب الأليم؟!! واعلم أن الكفر بشيء من هذه الأمور المذكورة, كالكفر بجميعها, لتلازمها, وامتناع وجود الإيمان ببعضها, دون بعض.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ↓
↓
 ↓
↓ثم قال " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا " الآية.
أي: من تكرر منه الكفر بعد الإيمان, فاهتدى, ثم ضل وأبصر, ثم عمي وآمن, ثم كفر واستمر على كفره, وازداد منه, فإنه بعيد من التوفيق والهداية, لأقوم الطريق, وبعيد عن المغفرة, لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها.
فإن كفره, يكون عقوبة وطبعا, لا يزول كما قال تعالى " فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ " .
" وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ " .
ودلت الآية: أنهم, إن لم يزدادوا كفرا, بل رجعوا إلى الإيمان, وتركوا ما هم عليه من الكفران, فإن الله يغفر لهم, ولو تكررت منهم الردة.
وإذا كان هذا الحكم في الكفر, فغيره - من المعاصي التي دونه - من باب أولى أن العبد لو تكررت منه, ثم عاد إلى التوبة, عاد الله له بالمغفرة.
أي: من تكرر منه الكفر بعد الإيمان, فاهتدى, ثم ضل وأبصر, ثم عمي وآمن, ثم كفر واستمر على كفره, وازداد منه, فإنه بعيد من التوفيق والهداية, لأقوم الطريق, وبعيد عن المغفرة, لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها.
فإن كفره, يكون عقوبة وطبعا, لا يزول كما قال تعالى " فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ " .
" وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ " .
ودلت الآية: أنهم, إن لم يزدادوا كفرا, بل رجعوا إلى الإيمان, وتركوا ما هم عليه من الكفران, فإن الله يغفر لهم, ولو تكررت منهم الردة.
وإذا كان هذا الحكم في الكفر, فغيره - من المعاصي التي دونه - من باب أولى أن العبد لو تكررت منه, ثم عاد إلى التوبة, عاد الله له بالمغفرة.
البشارة, تستعمل في الخير, وتستعمل في الشر بقيد, كما في هذه الآية.
يقول تعالى " بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ " أي: الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر, بأقبح بشارة وأسوإها, وهو العذاب الأليم.
يقول تعالى " بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ " أي: الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر, بأقبح بشارة وأسوإها, وهو العذاب الأليم.
الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ↓
↓
 ↓
↓وذلك بسبب محبتهم الكفار, وموالاتهم, ونصرتهم, وتركهم لموالاة المؤمنين.
فأي شيء حملهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟.
وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين.
ساء ظنهم بالله, وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين.
ولحظوا بعض الأسباب, التي عند الكافرين, وقصر نظرهم عما وراء ذلك.
فاتخذوا الكافرين أولياء, يتعززون بهم, ويستنصرون.
والحال أن العزة لله جميعا, فإن نواصي العباد بيده, ومشيئته نافذة فيهم.
وقد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين, ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين.
وإدالة العدو عليهم, إدالة غير مستمرة, فإن العاقبة والاستقرار, للمؤمنين.
وفي هذه الآية, الترهيب العظيم من موالاة الكافرين; وترك موالاة المؤمنين, وأن ذلك, من صفات المنافقين.
وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم, وبغض الكافرين وعداوتهم.
فأي شيء حملهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟.
وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين.
ساء ظنهم بالله, وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين.
ولحظوا بعض الأسباب, التي عند الكافرين, وقصر نظرهم عما وراء ذلك.
فاتخذوا الكافرين أولياء, يتعززون بهم, ويستنصرون.
والحال أن العزة لله جميعا, فإن نواصي العباد بيده, ومشيئته نافذة فيهم.
وقد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين, ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين.
وإدالة العدو عليهم, إدالة غير مستمرة, فإن العاقبة والاستقرار, للمؤمنين.
وفي هذه الآية, الترهيب العظيم من موالاة الكافرين; وترك موالاة المؤمنين, وأن ذلك, من صفات المنافقين.
وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم, وبغض الكافرين وعداوتهم.
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ↓
↓
 ↓
↓أي: وقد بيَّن الله لكم - فيما أنزل عليكم - حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر والمعاصي " أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا " أي: يستهان بها.
وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله, الإيمان بها, وتعظيمها وإجلالها, وتفخيمها.
وهذا هو المقصود بإنزالها, وهو الذي خَلَق الله الخَلْق لأجله.
فضد الإيمان, الكفر بها, وضد تعظيمها; الاستهزاء بها واحتقارها.
ويدخل في ذلك, مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم.
وكذلك المبتدعون, على اختلاف أنواعهم.
فإن احتجاجهم على باطلهم, يتضمن الاستهانة بآيات الله, لأنها لا تدل إلا على الحق, ولا تستلزم إلا صدقا.
بل وكذلك يدخل فيه, حضور مجالس المعاصي والفسوق, التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه, وتقتحم حدوده التي حدها لعباده.
ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم " حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ " أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها.
" إِنَّكُمْ إِذًا " أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكور " مَثَلُهُمْ " لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم, والراضي بالمعصية, كالفاعل لها.
والحاصل أن من حضر مجلسا, يعصى الله به, فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم, مع القدرة, أو القيام مع عدمها.
" إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا " كما اجتمعوا على الكفر والموالاة.
ولا ينفع المنافقين مجرد كونهم - في الظاهر - مع المؤمنين كما قال تعالى: " يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ " إلى آخر الآيات.
وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله, الإيمان بها, وتعظيمها وإجلالها, وتفخيمها.
وهذا هو المقصود بإنزالها, وهو الذي خَلَق الله الخَلْق لأجله.
فضد الإيمان, الكفر بها, وضد تعظيمها; الاستهزاء بها واحتقارها.
ويدخل في ذلك, مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم.
وكذلك المبتدعون, على اختلاف أنواعهم.
فإن احتجاجهم على باطلهم, يتضمن الاستهانة بآيات الله, لأنها لا تدل إلا على الحق, ولا تستلزم إلا صدقا.
بل وكذلك يدخل فيه, حضور مجالس المعاصي والفسوق, التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه, وتقتحم حدوده التي حدها لعباده.
ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم " حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ " أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها.
" إِنَّكُمْ إِذًا " أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكور " مَثَلُهُمْ " لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم, والراضي بالمعصية, كالفاعل لها.
والحاصل أن من حضر مجلسا, يعصى الله به, فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم, مع القدرة, أو القيام مع عدمها.
" إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا " كما اجتمعوا على الكفر والموالاة.
ولا ينفع المنافقين مجرد كونهم - في الظاهر - مع المؤمنين كما قال تعالى: " يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ " إلى آخر الآيات.
الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ↓
↓
 ↓
↓ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين, ومعاداتهم للمؤمنين فقال: " الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ " أي: ينتظرون الحالة التي تصيرون عليها, وتنتهون إليها, من خير أو شر, قد أعدوا لكل حالة جوابا بحسب نفاقهم.
" فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ " .
فيظهرون أنهم مع المؤمنين, ظاهرا وباطنا, ليسلموا من القدح والطعن عليهم, وليشركوهم في الغنيمة والفيء, ولينتصروا بهم.
" وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ " ولم يقل فتح, لأنه لا يحصل لهم فتح, يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة.
بل غاية ما يكون, أن يكون لهم نصيب غير مستقر, حكمة من الله.
فإذا كان ذلك " قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ " أي: نستولي عليكم " وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " .
أي: يتصنعون عندهم, بكف أيديهم عنهم, مع القدرة, ومنعهم من المؤمنين, بجميع وجوه المنع في تنفيرهم, وتزهيدهم في القتال, ومظاهرة الأعداء عليهم, وغير ذلك, مما هو معروف منهم.
" فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فيجازي المؤمنين, ظاهرا وباطنا, بالجنة, ويعذب المنافقين والمنافقات, والمشركين والمشركات.
" وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا " أي: تسلطا واستيلاء عليهم.
بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة, لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
ولا يزال الله, يحدث من أسباب النصر للمؤمنين, ودفع تسليط الكافرين, ما هو مشهود بالعيان.
حتى إن بعض المسلمين, الذين تحكمهم الطوائف الكافرة, قد بقوا محترمين لا يتعرضون لأديانهم, ولا يكونون مستصغرين عندهم.
بل لهم العز التام من الله, فلله الحمد, أولا وآخرا, وظاهرا وباطنا.
" فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ " .
فيظهرون أنهم مع المؤمنين, ظاهرا وباطنا, ليسلموا من القدح والطعن عليهم, وليشركوهم في الغنيمة والفيء, ولينتصروا بهم.
" وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ " ولم يقل فتح, لأنه لا يحصل لهم فتح, يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة.
بل غاية ما يكون, أن يكون لهم نصيب غير مستقر, حكمة من الله.
فإذا كان ذلك " قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ " أي: نستولي عليكم " وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " .
أي: يتصنعون عندهم, بكف أيديهم عنهم, مع القدرة, ومنعهم من المؤمنين, بجميع وجوه المنع في تنفيرهم, وتزهيدهم في القتال, ومظاهرة الأعداء عليهم, وغير ذلك, مما هو معروف منهم.
" فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فيجازي المؤمنين, ظاهرا وباطنا, بالجنة, ويعذب المنافقين والمنافقات, والمشركين والمشركات.
" وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا " أي: تسلطا واستيلاء عليهم.
بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة, لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
ولا يزال الله, يحدث من أسباب النصر للمؤمنين, ودفع تسليط الكافرين, ما هو مشهود بالعيان.
حتى إن بعض المسلمين, الذين تحكمهم الطوائف الكافرة, قد بقوا محترمين لا يتعرضون لأديانهم, ولا يكونون مستصغرين عندهم.
بل لهم العز التام من الله, فلله الحمد, أولا وآخرا, وظاهرا وباطنا.
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ↓
↓
 ↓
↓يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه, من قبيح الصفات, وشنائع السمات.
وأن طريقتهم مخادعة الله تعالى, أي: بما أظهروه من الإيمان, وأبطنوه من الكفران.
ظنوا أنه يروج على الله, ولا يعلمه, ولا يبديه لعباده, والحال أن الله خادعهم.
فمجرد وجود هذه الحال منهم, ومشيهم عليها, خداع لأنفسهم.
وأي خداع أعظم, ممن يسعى سعيا, يعود عليه بالهوان والذل والحرمان؟!!.
ويدل - بمجرده - على نقص عقل صاحبه, حيث جمع بين المعصية, ورآها حسنة, وظنها من العقل والمكر.
فلله ما يصنع الجهل والخذلان بصاحبه!!.
ومن خداعه لهم يوم القيامة, ما ذكره الله في قوله: " يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ " إلى آخر الآيات.
ومن صفاتهم أنهم " وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ " التي هي أكبر الطاعات العملية, إن قاموا " قَامُوا كُسَالَى " متثاقلين لها, متبرمين من فعلها.
والكسل, لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوبهم.
فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله, وإلى ما عنده, عادمة للإيمان, لم يصدر منهم الكسل.
" يُرَاءُونَ النَّاسَ " أي: هذا الذي انطوت عليه سرائرهم, وهذا مصدر أعمالهم, مراءاة الناس.
يقصدون رؤية الناس, وتعظيمهم, واحترامهم, ولا يخلصون لله.
فلهذا " وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا " لامتلاء قلوبهم من الرياء.
فإن ذكر الله تعالى, وملازمته, لا يكون إلا من مؤمن, ممتلئ قلبه, بمحبة الله وعظمته.
وأن طريقتهم مخادعة الله تعالى, أي: بما أظهروه من الإيمان, وأبطنوه من الكفران.
ظنوا أنه يروج على الله, ولا يعلمه, ولا يبديه لعباده, والحال أن الله خادعهم.
فمجرد وجود هذه الحال منهم, ومشيهم عليها, خداع لأنفسهم.
وأي خداع أعظم, ممن يسعى سعيا, يعود عليه بالهوان والذل والحرمان؟!!.
ويدل - بمجرده - على نقص عقل صاحبه, حيث جمع بين المعصية, ورآها حسنة, وظنها من العقل والمكر.
فلله ما يصنع الجهل والخذلان بصاحبه!!.
ومن خداعه لهم يوم القيامة, ما ذكره الله في قوله: " يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ " إلى آخر الآيات.
ومن صفاتهم أنهم " وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ " التي هي أكبر الطاعات العملية, إن قاموا " قَامُوا كُسَالَى " متثاقلين لها, متبرمين من فعلها.
والكسل, لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوبهم.
فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله, وإلى ما عنده, عادمة للإيمان, لم يصدر منهم الكسل.
" يُرَاءُونَ النَّاسَ " أي: هذا الذي انطوت عليه سرائرهم, وهذا مصدر أعمالهم, مراءاة الناس.
يقصدون رؤية الناس, وتعظيمهم, واحترامهم, ولا يخلصون لله.
فلهذا " وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا " لامتلاء قلوبهم من الرياء.
فإن ذكر الله تعالى, وملازمته, لا يكون إلا من مؤمن, ممتلئ قلبه, بمحبة الله وعظمته.
مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاء وَلاَ إِلَى هَؤُلاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً ↑
↑
 ↑
↑" مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ " .
أي: مترددين, بين فريق المؤمنين, وفريق الكافرين.
فلا من المؤمنين ظاهرا وباطنا, ولا من الكافرين ظاهرا وباطنا.
أعطوا باطنهم للكافرين, وظاهرهم للمؤمنين, وهذا أعظم ضلال يقدر.
ولهذا قال " وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا " أي: لن تجد طريقا لهدايته, ولا وسيلة لترك غوايته, لأنه انغلق عنه باب الرحمة, وصار بدله, كل نقمة.
فهذه الأوصاف المذمومة, تدل - بتنبيهها - على أن المؤمنين, متصفون بضدها, من الصدق والإخلاص, ظاهرا وباطنا.
وأنهم لا يجهل ما عندهم, من النشاط في صلاتهم, وعباداتهم, وكثرة ذكرهم لله تعالى.
وأنهم قد هداهم الله, ووفقهم للصراط المستقيم.
فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين, وليختر أيهما أولى به, والله المستعان.
أي: مترددين, بين فريق المؤمنين, وفريق الكافرين.
فلا من المؤمنين ظاهرا وباطنا, ولا من الكافرين ظاهرا وباطنا.
أعطوا باطنهم للكافرين, وظاهرهم للمؤمنين, وهذا أعظم ضلال يقدر.
ولهذا قال " وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا " أي: لن تجد طريقا لهدايته, ولا وسيلة لترك غوايته, لأنه انغلق عنه باب الرحمة, وصار بدله, كل نقمة.
فهذه الأوصاف المذمومة, تدل - بتنبيهها - على أن المؤمنين, متصفون بضدها, من الصدق والإخلاص, ظاهرا وباطنا.
وأنهم لا يجهل ما عندهم, من النشاط في صلاتهم, وعباداتهم, وكثرة ذكرهم لله تعالى.
وأنهم قد هداهم الله, ووفقهم للصراط المستقيم.
فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين, وليختر أيهما أولى به, والله المستعان.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ↓
↓
 ↓
↓لما ذكر أن من صفات المنافقين, اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين, نهى عباده المؤمنين أن يتصفوا بهذه الحالة القبيحة, وأن يشابهوا المنافقين, فإن ذلك موجب لأن " تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا " أي: حجة واضحة على عقوبتكم.
فإنه قد أنذرنا وحذرنا منها, وأخبرنا بما فيها من المفاسد.
فسلوكها - بعد هذا - موجِب للعقاب.
وهذه الآية, دليل على كمال عدل الله, وأن الله لا يُعَذِّب أحدا; قبل قيام الحجة عليه.
وفيه التحذير من المعاصي; فإن فاعلها يجعل لله عليه سلطانا مبينا.
فإنه قد أنذرنا وحذرنا منها, وأخبرنا بما فيها من المفاسد.
فسلوكها - بعد هذا - موجِب للعقاب.
وهذه الآية, دليل على كمال عدل الله, وأن الله لا يُعَذِّب أحدا; قبل قيام الحجة عليه.
وفيه التحذير من المعاصي; فإن فاعلها يجعل لله عليه سلطانا مبينا.
يخبر تعالى, عن مآل المنافقين, أنهم في أسفل الدركات من العذاب, وأشر الحالات من العقاب.
فهم تحت سائر الكفار, لأنهم شاركوهم بالكفر بالله, ومعاداة رسله.
وزادوا عليهم, المكر والخديعة, والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين, على وجه لا يشعر به ولا يحس.
ورتبوا على ذلك, جريان أحكام الإسلام عليهم, واستحقاق ما لا يستحقونه.
فبذلك ونحوه, استحقوا أشد العذاب.
وليس لهم منقذ من عذابه, ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه.
وهذا عام لكل منافق, إلا مَنْ مَنَّ الله عليهم بالتوبة من السيئات " وَأَصْلَحُوا " له الظواهر والبواطن " وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ " والتجأوا إليه, في جلب منافعهم, ودفع المضار عنهم.
" وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ " الذي هو الإسلام, والإيمان والإحسان " لِلَّهِ " .
فقصدوا وجه الله, بأعمالهم الظاهرة والباطنة, وسلموا من الرياء والنفاق.
فمن اتصف بهذه الصفات " فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ " أي: في الدنيا, والبرزخ, ويوم القيامة.
" وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا " لا يعلم كنهه إلا الله, مما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر.
وتأمل كيف خص الاعتصام والإخلاص, بالذكر, مع دخولهما في قوله: " وَأَصْلَحُوا " لأن الاعتصام والإخلاص, من جملة الإصلاح, لشدة الحاجة إليهما, خصوصا في هذا المقام الحرج, الذي تمكن فيه النفاق من القلوب.
فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله, ودوام اللجأ والافتقار إليه, في دفعه, وكون الإخلاص منافيا كل المنافاة للنفاق.
فذكرهما لفضلهما, وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما, ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما.
وتأمل كيف - لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين - لم يقل " وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا " , مع أن السيئات فيهم.
بل قال " وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا " .
لأن هذه القاعدة الشريفة - لم يزل الله يبدئ فيها ويعيد, إذا كان السياق في بعض الجزئيات, وأراد أن يرتب عليه ثوابا أو عقابا وكان ذلك مشتركا بينه وبين الجنس الداخل فيه.
رتب الثواب, في مقابلة الحكم العام, الذي تندرج تحته, تلك القضية وغيرها.
ولئلا يتوهم اختصاص الحكم, بالأمر الجزئي, فهذا من أسرار القرآن البديعة.
فالتائب من المنافقين, مع المؤمنين, وله ثوابهم.
فهم تحت سائر الكفار, لأنهم شاركوهم بالكفر بالله, ومعاداة رسله.
وزادوا عليهم, المكر والخديعة, والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين, على وجه لا يشعر به ولا يحس.
ورتبوا على ذلك, جريان أحكام الإسلام عليهم, واستحقاق ما لا يستحقونه.
فبذلك ونحوه, استحقوا أشد العذاب.
وليس لهم منقذ من عذابه, ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه.
وهذا عام لكل منافق, إلا مَنْ مَنَّ الله عليهم بالتوبة من السيئات " وَأَصْلَحُوا " له الظواهر والبواطن " وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ " والتجأوا إليه, في جلب منافعهم, ودفع المضار عنهم.
" وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ " الذي هو الإسلام, والإيمان والإحسان " لِلَّهِ " .
فقصدوا وجه الله, بأعمالهم الظاهرة والباطنة, وسلموا من الرياء والنفاق.
فمن اتصف بهذه الصفات " فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ " أي: في الدنيا, والبرزخ, ويوم القيامة.
" وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا " لا يعلم كنهه إلا الله, مما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر.
وتأمل كيف خص الاعتصام والإخلاص, بالذكر, مع دخولهما في قوله: " وَأَصْلَحُوا " لأن الاعتصام والإخلاص, من جملة الإصلاح, لشدة الحاجة إليهما, خصوصا في هذا المقام الحرج, الذي تمكن فيه النفاق من القلوب.
فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله, ودوام اللجأ والافتقار إليه, في دفعه, وكون الإخلاص منافيا كل المنافاة للنفاق.
فذكرهما لفضلهما, وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما, ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما.
وتأمل كيف - لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين - لم يقل " وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا " , مع أن السيئات فيهم.
بل قال " وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا " .
لأن هذه القاعدة الشريفة - لم يزل الله يبدئ فيها ويعيد, إذا كان السياق في بعض الجزئيات, وأراد أن يرتب عليه ثوابا أو عقابا وكان ذلك مشتركا بينه وبين الجنس الداخل فيه.
رتب الثواب, في مقابلة الحكم العام, الذي تندرج تحته, تلك القضية وغيرها.
ولئلا يتوهم اختصاص الحكم, بالأمر الجزئي, فهذا من أسرار القرآن البديعة.
فالتائب من المنافقين, مع المؤمنين, وله ثوابهم.
إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ↓
↓
 ↓
↓ثم أخبر تعالى, عن كمال غناه, وسعة حلمه, ورحمته; وإحسانه فقال: " مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ " والحال أن الله شاكر عليم.
يعطي المتحملين لأجله; الأثقال, الدائبين في الأعمال; جزيل الثواب وواسع الإحسان.
ومن ترك شيئا لله, أعطاه الله خيرا منه.
ومع هذا, يعلم ظاهركم وباطنكم, وأعمالكم, وما تصدر عنه من إخلاص وصدق, وضد ذلك.
وهو يريد التوبة والإنابة منكم والرجوع إليه.
فإذا أنبتم إليه, فأي شيء يفعل بعذابكم؟ فإنه لا يتشفى بعذابكم, ولا ينتفع بعقابكم.
بل العاصي لا يضر إلا نفسه, كما أن عمل المطيع, لنفسه.
والشكر هو: خضوع القلب, واعترافه بنعمة الله, وثناء اللسان على المشكور.
وعمل الجوارح بطاعته, وأن لا يستعين بنعمه على معاصيه.
يعطي المتحملين لأجله; الأثقال, الدائبين في الأعمال; جزيل الثواب وواسع الإحسان.
ومن ترك شيئا لله, أعطاه الله خيرا منه.
ومع هذا, يعلم ظاهركم وباطنكم, وأعمالكم, وما تصدر عنه من إخلاص وصدق, وضد ذلك.
وهو يريد التوبة والإنابة منكم والرجوع إليه.
فإذا أنبتم إليه, فأي شيء يفعل بعذابكم؟ فإنه لا يتشفى بعذابكم, ولا ينتفع بعقابكم.
بل العاصي لا يضر إلا نفسه, كما أن عمل المطيع, لنفسه.
والشكر هو: خضوع القلب, واعترافه بنعمة الله, وثناء اللسان على المشكور.
وعمل الجوارح بطاعته, وأن لا يستعين بنعمه على معاصيه.
لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ↓
↓
 ↓
↓يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول, أي: يبغض ذلك ويمقته, ويعاقب عليه.
ويشمل ذلك, جميع الأقوال السيئة, التي تسوء وتحزن, كالشتم, والقذف, والسب ونحو ذلك فإن ذلك كله, من المنهي عنه, الذي يبغضه الله.
ويدل مفهومها, أنه يحب الحسن من القول, كالذكر, والكلام الطيب اللين.
وقوله " إِلَّا مَنْ ظُلِمَ " أي: فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه, ويشتكي منه, ويجهر بالسوء لمن جهر له به, من غير أن يكذب عليه, ولا يزيد على مظلمته, ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه.
ومع ذلك, فعفوه, وعدم مقابلته, أولى كما قال تعالى: " فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ " .
" وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا " ولما كانت الآية, قد اشتملت على الكلام السيئ, والحسن, والمباح, أخبر تعالى, أنه سميع, فيسمع أقوالكم, فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم.
وفيه أيضا ترغيب على القول الحسن " عَلِيمٌ " بنياتكم ومصدر أقوالكم.
يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول, أي: يبغض ذلك ويمقته, ويعاقب عليه.
ويشمل ذلك, جميع الأقوال السيئة, التي تسوء وتحزن, كالشتم, والقذف, والسب ونحو ذلك فإن ذلك كله, من المنهي عنه, الذي يبغضه الله.
ويدل مفهومها, أنه يحب الحسن من القول, كالذكر, والكلام الطيب اللين.
وقوله " إِلَّا مَنْ ظُلِمَ " أي: فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه, ويشتكي منه, ويجهر بالسوء لمن جهر له به, من غير أن يكذب عليه, ولا يزيد على مظلمته, ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه.
ومع ذلك, فعفوه, وعدم مقابلته, أولى كما قال تعالى: " فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ " .
" وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا " ولما كانت الآية, قد اشتملت على الكلام السيئ, والحسن, والمباح, أخبر تعالى, أنه سميع, فيسمع أقوالكم, فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم.
وفيه أيضا ترغيب على القول الحسن " عَلِيمٌ " بنياتكم ومصدر أقوالكم.
ويشمل ذلك, جميع الأقوال السيئة, التي تسوء وتحزن, كالشتم, والقذف, والسب ونحو ذلك فإن ذلك كله, من المنهي عنه, الذي يبغضه الله.
ويدل مفهومها, أنه يحب الحسن من القول, كالذكر, والكلام الطيب اللين.
وقوله " إِلَّا مَنْ ظُلِمَ " أي: فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه, ويشتكي منه, ويجهر بالسوء لمن جهر له به, من غير أن يكذب عليه, ولا يزيد على مظلمته, ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه.
ومع ذلك, فعفوه, وعدم مقابلته, أولى كما قال تعالى: " فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ " .
" وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا " ولما كانت الآية, قد اشتملت على الكلام السيئ, والحسن, والمباح, أخبر تعالى, أنه سميع, فيسمع أقوالكم, فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم.
وفيه أيضا ترغيب على القول الحسن " عَلِيمٌ " بنياتكم ومصدر أقوالكم.
يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول, أي: يبغض ذلك ويمقته, ويعاقب عليه.
ويشمل ذلك, جميع الأقوال السيئة, التي تسوء وتحزن, كالشتم, والقذف, والسب ونحو ذلك فإن ذلك كله, من المنهي عنه, الذي يبغضه الله.
ويدل مفهومها, أنه يحب الحسن من القول, كالذكر, والكلام الطيب اللين.
وقوله " إِلَّا مَنْ ظُلِمَ " أي: فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه, ويشتكي منه, ويجهر بالسوء لمن جهر له به, من غير أن يكذب عليه, ولا يزيد على مظلمته, ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه.
ومع ذلك, فعفوه, وعدم مقابلته, أولى كما قال تعالى: " فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ " .
" وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا " ولما كانت الآية, قد اشتملت على الكلام السيئ, والحسن, والمباح, أخبر تعالى, أنه سميع, فيسمع أقوالكم, فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم.
وفيه أيضا ترغيب على القول الحسن " عَلِيمٌ " بنياتكم ومصدر أقوالكم.
إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ↓
↓
 ↓
↓ثم قال تعالى " إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ " وهذا يشمل كل خير, قولي, وفعلي, ظاهر, وباطن, من واجب, ومستحب.
" أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ " أي: عمن أساء إليكم في أبدانكم, وأموالكم, واعراضكم, فتسمحوا عنه, فإن الجزاء من جنس العمل.
فمن عفا لله, عفا الله عنه, ومن أحسن, أحسن الله إليه, فلهذا قال: " فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا " أي: يعفو عن زلات عباده, وذنوبهم العظيمة, فيسدل عليهم ستره, ثم يعاملهم بعفوه التام, الصادر عن قدرته.
وفي هذه الآية, إرشاد إلى التدبر في معاني أسماء الله وصفاته, وأن الخلق والأمر, صادر عنها, وهي مقتضية له, ولهذا يعلل الأحكام, بالأسماء الحسنى, كما في هذه الآية.
لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء, رتب على ذلك, بأن أحالنا على معرفة أسمائه, وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص قال " إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ " إلى " وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا " .
" أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ " أي: عمن أساء إليكم في أبدانكم, وأموالكم, واعراضكم, فتسمحوا عنه, فإن الجزاء من جنس العمل.
فمن عفا لله, عفا الله عنه, ومن أحسن, أحسن الله إليه, فلهذا قال: " فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا " أي: يعفو عن زلات عباده, وذنوبهم العظيمة, فيسدل عليهم ستره, ثم يعاملهم بعفوه التام, الصادر عن قدرته.
وفي هذه الآية, إرشاد إلى التدبر في معاني أسماء الله وصفاته, وأن الخلق والأمر, صادر عنها, وهي مقتضية له, ولهذا يعلل الأحكام, بالأسماء الحسنى, كما في هذه الآية.
لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء, رتب على ذلك, بأن أحالنا على معرفة أسمائه, وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص قال " إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ " إلى " وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا " .
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ↓
↓
 ↓
↓هنا قسمان, قد وضحا لكل أحد مؤمن بالله, وبرسله كلهم, وكتبه, وكافر بذلك كله.
وبقي قسم ثالث: وهو: الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل, دون بعض, وأن هذا سبيل ينجيه من عذاب الله, إن هذا إلا مجرد أماني.
فإن هؤلاء, يريدون التفريق بين الله وبين رسله.
فإن من تولى الله حقيقة, تولى جميع رسله, لأن ذلك من تمام توليه.
ومن عادى أحدا من رسله, فقد عادى الله, وعادى جميع رسله كما قال تعالى: " مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ " الآيات.
وبقي قسم ثالث: وهو: الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل, دون بعض, وأن هذا سبيل ينجيه من عذاب الله, إن هذا إلا مجرد أماني.
فإن هؤلاء, يريدون التفريق بين الله وبين رسله.
فإن من تولى الله حقيقة, تولى جميع رسله, لأن ذلك من تمام توليه.
ومن عادى أحدا من رسله, فقد عادى الله, وعادى جميع رسله كما قال تعالى: " مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ " الآيات.